١



كانت أسيوط بلدًا مليونية في تعداد سكانها، لكن الأثرياء والمشاهير فيها قلة قليلة نعرفهم بالاسم. منهم هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، وبيت أبو حميد، الذين كانوا أثرياء من بزنس المقاولات.
تخيل أنه كان بوسعنا التصويت على موهبة هادي خشبة، التي جلبت له الشهرة والثراء، بحيث نأخذ منها نسبة معينة ونوزعها على بقية الصبية في أسيوط من أمثالنا، الذين كانوا يتمنون أن يستمروا في مشوار الكرة.
أو تخيل أننا أدركنا استحالة هذا، فقلنا ما عليه شي، خله يتهنأ بموهبته، ويكد ويتعب. متعة يا أخي وسنتركها له! أما نحن سنكتفي بأن نحصل على نسبة من ثروته، التي هي ثمرة موهبته وكدِّه.
تخيل أيضًا أننا فعلنا الشيء نفسه مع عائلة أبو حميد؟!
تخيل لو جمعنا كل أثرياء أسيوط، واستفتينا شعب أسيوط على الاستيلاء على جزء كبير من ثروتهم، بالقانون؟
لن نسميه استيلاءً طبعًا. سنسميه مشاركة. هذا سيخفف قليلًا من لفظ “الاستيلاء” والعياذ بالله.
وطبعًا لن نشاركهم السراء والضراء. سنشاركهم فقط في الزمان الحسن. لو أصيب هادي خشبة، لو خسر أبو حميد، سندير لهم ظهورنا يوم المحن.
من الطبيعي والمنطقي أن يجد شعب أسيوط هذه فكرة جيدة، لن يصير هادي خشبة مميزًا عن أقرانه من اللاعبين ولا عن أمثالنا من العاديين، سيصير ابن العائلة الذي يخرج ليعمل ثم يعود بالمال ليودعه البيت ويترك الكبار يتصرفون فيه. ولن يصير أبو حميد مميزًا عن أقرانه من المقاولين ولا جيرانه وجيراننا. سنضيق الفوارق بين الطبقات.
ثم ربما يكرمنا الله بشخص مثقف، يملك ناصية الكلام، ليسمي هذه السياسة “عدالة اجتماعية”. هكذا سننتقل إلى خانة الفعل الإيجابي.
بغض النظر عن المسميات، ماديًا لن يكون الموضوع مجديًا بالشكل الذي تخيلناه:
ستنقسم الثروة الأصلية إلى مقادير ضئيلة جدًا. حين توزع علينا لن تضيف إلى ثرواتنا الشخصية شيئًا يذكر.
ثرواتنا في شكلها الجديد، بعد الزيادة، لن تعبر عتبة الاستثمار. أي ربما تجعلنا نعيش أفضل لمدة شهر، أو سنة، لكنها لن تكفي لاستثمارها.
هذا يعني أن الزيادة ستدخل في بند الاستهلاك، لا الإنتاج. سيزيد حجم الطلب في السوق، ولكن أحدًا لن يملك رأسمالًا استثماريًا لكي يزيد حجم الإنتاج. سترتفع الأسعار. أرجح الظن أننا لن نتهنأ بالاستفادة من “نصيب الثروة”الذي حصلنا عليه.
تبدو عبارة” الاستيلاء على الثروة” كاريكاتورية ومبالغًا فيها، في حين أنها العبارة الجادة الوحيدة في كل الشعارات المحيطة بها، وعلى اختلاف الأشكال التي يتخذها، في السياسات الضريبية، والجمركية، وفي إجراءات إدارة الاستثمار والنشاط الاقتصادي. سواء استهدف الأصول أو استهدف الأرباح، والعوائد، والمداخيل.
السياسات الضريبية التي تستهدف الربح أشد خطرًا على الاقتصاد من الاستيلاء الصريح على الثروة، وأكثر خبثًا.
أشد خطرًا:
الاستيلاء على الثروة يسمح بتراكم ثروة، ثم يأتي في لحظة وينقض عليها، بعد أن صار لها تاريخ يحكى، ويمكن تقييمه. كما نستطيع تقييم أداء مصر مثلًا في حقبة ما قبل نزع الثروة في الخمسينيات. وهو أيضًا إشارة واضحة إلى تغير جذري في توجه البلد الاقتصادي، عادة ما تدفع ثمنه مباشرة حين يأخذ المستثمرون حذرهم.
أما الاستيلاء على الربح بصفة دورية فـ “قصقصة ريش”، لا يعطي للمجتمع الفرصة لكي يرى ما يمكن أن تفعله السياسات الاقتصادية الداعمة للربح من أثر إيجابي في المجتمع.. ولا يتبقى أمام الناس سوى الاستماع إلى الكلام النظري الذي لا تدعمه التجارب العملية.
أكثر خبثًا:
لأن سياسات “قصقصة الريش” تستهدف العنصر النشط في بنية الثروة، العنصر الذي يعاد تدويره بما يخدم توسع الاستثمار، والمكافأة التي ينالها المستثمرون على مخاطرتهم بأموالهم، والذي يعوضهم عن أيام خسارة مقبلة، ويقلل من أثرها، فيشجعهم على الاستمرار.
كما أنها تأتي في صورة ممارسة ديمقراطية “عادلة”، مشفوعة بدعاية حقوقية، تشتت الذهن عن التفكير فيها منطقيًا وبراجماتيًا وأخلاقيًا.
أما الأدهى من هذا وذاك فالبعد المعنوي: السياسة الاقتصادية للمجتمع لها نفس أثر سلوك الأسرة على قيم أطفالها. السياسة الاقتصادية في أمريكا خلقت مجتمعًا يصفق للربح وبه يحتفي. السياسة الاقتصادية لدول أخرى خلقت مجتمعات مشغولة دائمًا بوضع سقف للطموح. المجتمع الأول يغري العقول المتميزة، والمجتمع الثاني ينفرها ويطردها.
نبدأ إذن من السؤال البراجماتي الأساسي: هل يستفيد المجتمع أكثر لو تركنا الربح لـ المستثمرين الذين حققوه، أم لو سحبنا الجزء الأكبر منه من أيديهم وأدخلناه في “المال العام”؟


من أصل 6 مشروعات جديدة في الولايات المتحدة، ٣ فقط تستطيع الاستمرار بعد أربع سنوات، و٣ تخسر وتخرج من السوق.
لا يتحدث الإعلام ولا الساسة كثيرًا عن هذا الجانب من حياة المستثمرين. هذا يوحي لنا بأن الاستثمار يساوي الربح فقط، والتشاركية تعني المشاركة في الربح فقط. لكن، كما رأينا، احتمالات الخسارة والربح متساوية. هذه الإحصائية لها علاقة بوجهين آخرين في نقاش الاستثمار والربح:
أولهما فهم الطبيعة الانتخابية للسوق. لا يبقى في مجال الاستثمار إلا من أثبتوا قدرات معينة في إدارة المال، واتخاذ القرارات، والبصيرة التجارية، تمكنهم من تنمية مشروعاتهم وإنجاحها. الحظ موجود، لكن الحظ لا يصنع نجاحًا مستدامًا. لا بد من الاجتهاد والموهبة لكي تضعك حيث يبحث الحظ عن وجوه يحسن إليها. هؤلاء هم المستثمرون الذين استمروا فعرفناهم.
ثانيهما رؤية الرحلة لا الجائزة التي في نهايتها. حاسدو الربح يختارون شركات كبرى في العالم، نماذج استثنائية للغاية، ذات أرباح خرافية (وخسائر خرافية أيضًا حين تحدث)، ويقدمونها لك مقياسًا على الربح الفاحش الكفيل بزغللة العيون، وتشتيت الرؤية، وإنعاش مشاعر الحسد حتى في أكثر الناس قناعة.
يتجاهلون حقيقة أن معظم هذه الشركات الكبرى كانت يومًا شركات ناشئة، لم تكن لتتمدد وتتوسع لو لم يسمح لها المجتمع الذي عملت فيه بمراكمة قدر من الربح تستخدمه للتوسع. هذه الشركات، سواء توظف شخصين اثنين أو عشرات الأشخاص، تلتزم بدفع رواتب وضرائب وتأمينات لكل موظفيها، بغض النظر عن كون الشركة رابحة أو خاسرة، هذه ضريبة تخرج من المنبع، وتشملها ميزانية الشركة بشكل سنوي، ويتستفيد منها المجتمع بغض النظر عن المصير النهائي للشركة.
فكر في أبل ما قبل أبل، ومايكروسوفت ما قبل مايكروسوفت. فكر في شركات كبرى رأينا قفزاتها وانكساراتها خلال عقود، وأخرى حملت نفس الأفكار لكنها لم تنجح لسبب أو لآخر. ارصد أيضًا الشركات – حتى الكبرى منها – التي خرجت من السوق أو تراجعت قيمتها.
هذا التوسع، فضلًا عن فرص العمل التي يوفرها والخبرات المهارية التي يراكمها، يسمح أيضًا للشركة بالمخاطرة في أفكار رائدة، لم يجربها أحد من قبل. من الصعب على شركة لا تملك حيز أمان مادي كافيًا أن تخاطر في آفاق جديدة. بعض الشركات خاطرت في فترة التحول إلى الديجيتال في إصدار راديوهات ومسجلات ديجيتال، وما هو إلا عام واحد وظهر الآي فون، فخسرت المخاطرة خسارة مبينة.
وجود قدر جيد من الأرباح مفيد في توسع الاستثمار، ومفيد بصفة خاصة في توسع الابتكار. لنفترض أننا في بداية القرن السابق، وأن هناك فكرة جديدة اسمها الطائرات. مجال جديد لا نعلم عنه شيئًا، وأي استثمار فيه مخاطرة. لن تخرج الفكرة إلى النور إلا بمستثمر يرعى إنتاج النموذج الأول. ليس هذا مبلغًا سهلًا. النموذج الأول من أي فكرة مكلف للغاية.
الآن لنفترض أن الفكرة نجحت، ودخلت مرحلة التصنيع. التوسع المبني على هذه الفكرة لن يتمثل فقط في الرغبة في صناعة مزيد من الطائرات بعد نجاح التجربة. هناك مستثمرون آخرون سيدخلون إلى المجال. يحتاج الجميع إلى عدد مضاعف من مصممي الطائرات هندسيًا، ثم معاهد للتدريب على صناعة التصميمات، ثم طيارين، وخبراء ميكانيكا. سنحتاج أيضًا إلى مصانع لمستلزمات الطائرة، من أول الكاوتشوك، إلى الصامولة، إلى الصناعات الأكثر تعقيدًا الخاصة بالصعود والهبوط وحسابات الضغط الجوي والسرعة.
بعد ذلك سندخل مرحلة الإضافات الابتكارية. الاختراع الأول نجح، لكن آلافًا من الإضافات الابتكارية ستستمر. من دخول العجلات وخروجها، إلى تطوير الموتورات، إلى تطوير الكابينة، إلى تطوير الكراسي، إلى تطوير الحمامات، إلى تطوير مستلزمات خدمة الطعام، إلى تطوير وسائل الترفيه، إلى تطوير الاتصالات. لم يتوقف الابتكار فيه منذ طارت أول طائرة في بداية القرن السابق وحتى القرن الحالي.
ثم لدينا الصناعات المتلامسة مع الطائرة، كبناء المطارات، والإشارات، وتدريب أطقم العمل، والمضيفين والمضيفات، وخدمات زنة الحقائب ونقلها، فهذا عالم آخر.
هذه صفة أساسية في الاقتصاد الحديث. لم تكن غائبة تمامًا في الاقتصاد القديم. اكتشاف الحديد وطريقة تطويعه أحدث ثورة اقتصادية في السابق، لكن الفارق في عصرنا الحديث – المبني على قدر أكبر من المعرفة – أن جوانب الابتكار لا نهائية.
تطور بهذا الشكل غيَّر مفهوم الربح عنه في عصر الاقتصاد الريعي القديم، حين كانت فرص الابتكار قليلة للغاية. وكان الناس يفكرون في الاقتصاد كما يفكر أفراد عائلة في حلة محشي. إن أكل شخص “أكثر من نصيبه” قل نصيب فرد آخر.
الاقتصاد الحديث قائم على فكرة الربح المتبادل. كلما ربح مزيد من الناس كلما ازدادت فرصتك في أن تربح. الربح نفسه هو الضامن لهذا. لأن مجالات النشاط الاقتصادي تجذب المستثمرين مع مظنة الربح، فإن قلت الأرباح بسبب تزايد المستثمرين في المجال خلق هذا دافع تطوير إلى مجالات جديدة، وفرص عمل جديدة، وفرص زيادة ثروة جديدة.
الربح أيضًا يضمن كفاءة السوق بإخراج الخاسرين منه أولًا بأول. من هم الخاسرون؟ الخاسرون من فاتتهم مهارات السوق، إما لافتقادهم إليها من الأساس، أو لأن الزمن تجاوز مهاراتهم. وهذا يعني انتقال أدوات إدارة الاستثمار، المال، إلى الأمهر في مهارة إدارته.
فهل الموظفون الحكوميون هم الأمهر والأحرص على إدارة المال بكفاءة؟

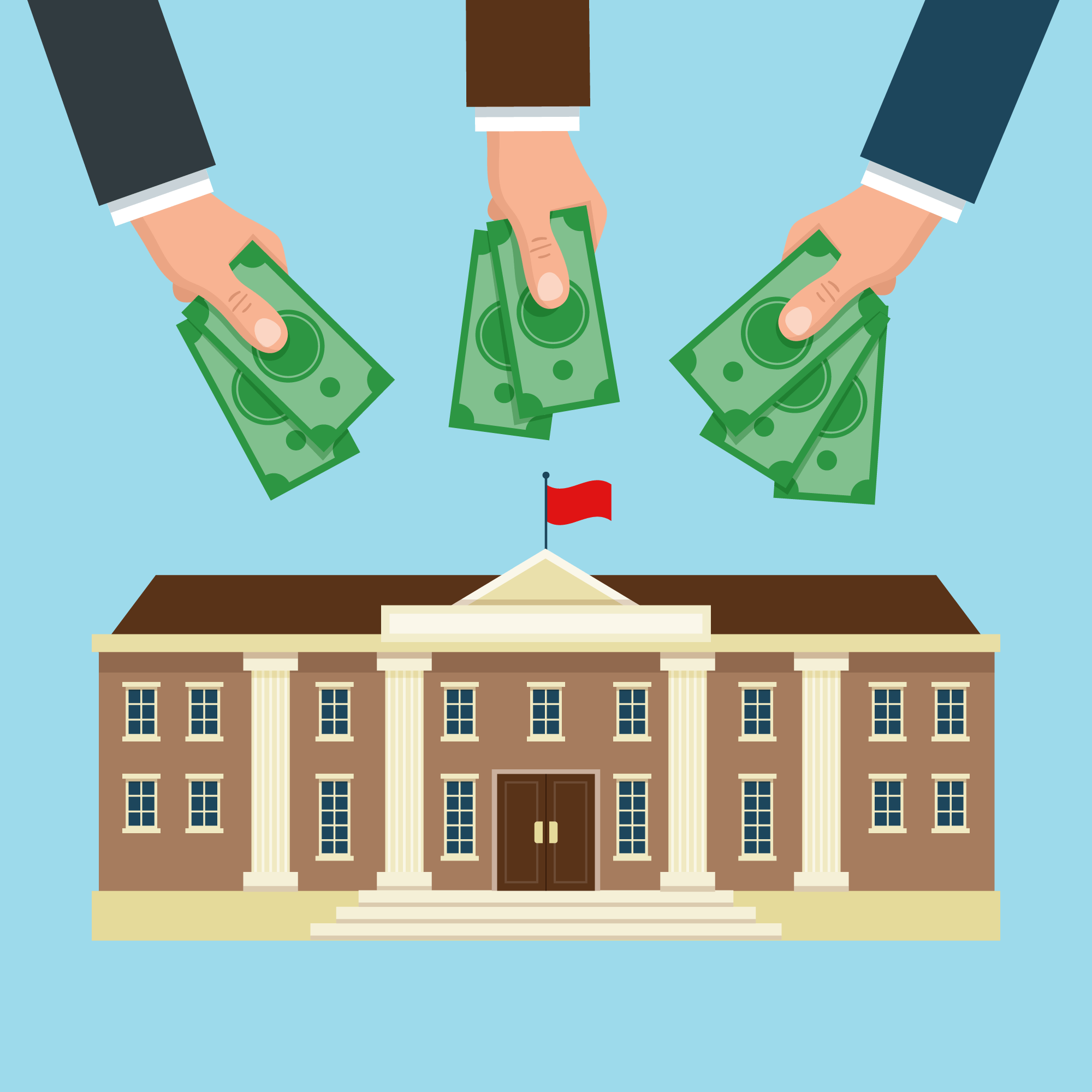
لو كان دخلك مليون دولار شهريًا ستعيش في مستوى مرفه، لو صار دخلك عشرة ملايين فلن يتغير مستوى معيشتك. سيكون الدافع الوحيد لاستمرارك في تحقيق مزيد من الأرباح هو الفضيلة الغريزية المشتركة لنجوم البزنس في العالم، الرغبة في العمل والتفوق والتملك.
الفضيلة الغائبة عند الموظف الحكومي، الذي يدير الأموال العامة.
قارن هذا بتحويل الأموال إلى موظفين حكوميين، بلا خبرة استثمارية، يتخذون القرارات بغير خوف من خسارة أموالهم الشخصية، وغالبًا دون خوف من فقدان حتى مناصبهم الإدارية. المال العام سيتوجه إلى تحقيق مكسب سياسي لا اقتصادي، كتشغيل عدد كبير من الموظفين، بدافع خفض أرقام البطالة. أو يتوجه إلى تغطية مشاريع خاسرة سابقة. في كل الأحوال سيدار بعقلية الموظف الحكومي وأولوياته، وهي سيئة للغاية حين نخرج عن إطار الخيارات الضرورية (المرافق والمهام الضرورية).
ثم هناك ما هو أهم من الجدل النظري. التجربة العملية. الفارق واضح بين مجتمعات “المال العام” ومجتمعات المال الخاص.
إن كان الموضوع بسيطًا وواضحًا ومثبتًا بالتجربة العملية، فلماذا تختار مجتمعات تقليص أرباح المستثمرين بفرض ضرائب إضافية، ثم تحويل هذا المال إلى موظفين حكوميين؟
وسأبدأ من النقطة التي يساء فهمها كثيرًا.

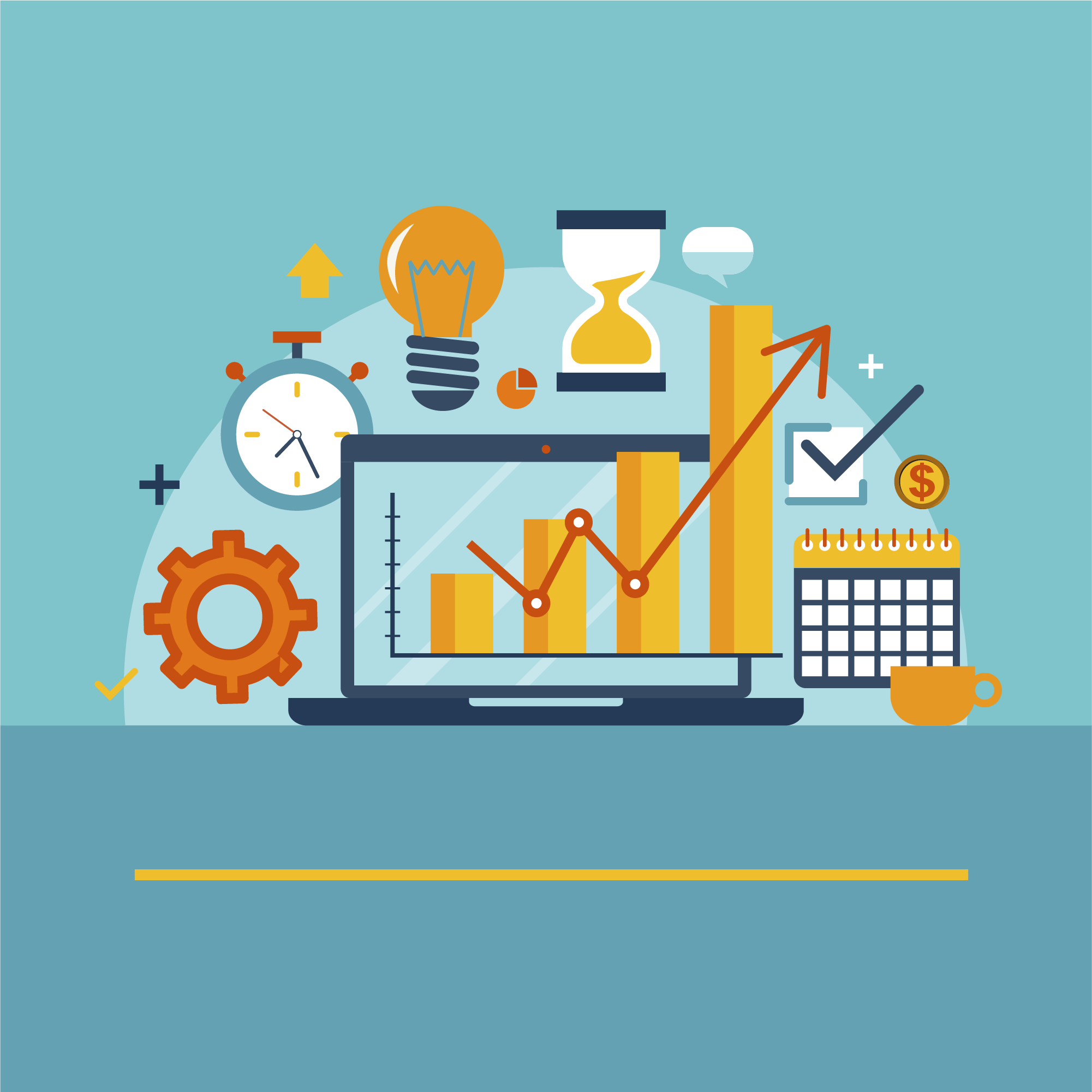
هناك أكثر من عامل يجعل السياسات المخربة للاقتصاد أسرع انتشارًا ورواجًا بين الجمهور من السياسات الداعمة له:
لو عرضت على سكان حينا أن يشاركوا المليونير في ماله، أو على المستأجرين أن يشاركوا المالك في شققه السكنية، ماذا على وجه الأرض يجعلنا نرفض هذا؟
نحن ميالون إلى تعظيم أرباحنا. إلى تحقيق أكبر ربح ممكن بأقل جهد ممكن؛ فالنتيجة الحتمية لعرض كهذا أن توافق عليه الأغلبية، ظانة أنها مستفيدة منه. العين تنظر إلى المتفوق بغيرة، لكننا نختلف في سلوكنا. منا من يأكل الحقد جسده، ومنا من يدفعه هذا إلى التنافس ومحاولة تحسين وضعه.
حين تدير المجتمع بفلسفة تجعل أفراده قادرين على الحصول بالقانون على ما كانوا في ظروف أخرى سيكتفون فيه بالغيرة أو الحسد أو الغبطة، أو الاجتهاد للمنافسة، فأنت في الحقيقة تقول للحسد إشارتك خضرا. تخلق كرة ثلج حقوقية تفترض أن من حقك تمامًا كما حصلت على ٢٠٪ من هذا، وعلى شقة بمقابل زهيد من ذاك، أن تحصل على ٨٠٪ ممن هو أغنى منى. لقد اقتطعت ٨٠٪ من دخله، من الفارق بينك وبينه، في خطوة واحدة، قانونية، وأنت مستريح الضمير. تركت له ٢٠٪ “يعيشوه كويس”.
مع ضرائب الاستيلاء على الربح، المعروفة بالضرائب التصاعدية، تطالب المستثمر أو غيره من أصحاب الدخول المرتفعة، ليس فقط بدفع مبلغ أكبر عن مجمل ثروته، إنما بدفع مبلغ أكبر عن كل ١٠٠ جنيه من ثروته. تقسم ثروته إلى وحدات، وتعاقبه في كل وحدة منها بمضاعفة الخصم.
لقد استجبت لرغبة وحيدة هي إرضاء “الحس العقابي” لمن تفوقوا في إدارة المال، أو في تجارة مهاراتهم المطلوبة في عصر معين. حس عقابي لن تستطيع أن تفعل مثله مع من تفوقوا في مواهب أخرى مضرة للاقتصاد الجماعي. ستظهر غرابته لو ذهبت إلى صاحب أولاد كثيرين وقلت له إن هذا زائد عن حاجتك، ولدينا آخرون ليس لديهم أولاد، فأعطنا عشرين في المئة من أولادك حتى الخمسة، ترتفع النسبة إلى ٦٠ في المئة لو عندك عشرة.
هل يمكن أن تفعل هذا؟!
لا يمكن. رغم أن “موهبة” الأخير تحمل اقتصاد البلد أعباءً ثقيلة، أما الأول فموهبته تخفف الأعباء عن اقتصاد البلد ويفتح فرص عمل.
نحن نحبط دافع المنافسة وحس المسؤولية لدى الأقل حظوة.
ونحيي دافع القلق وعدم الجدوى لدى الأكثر كفاءة في مهارة إدارة المال والبزنس.
ونخلق شعورًا بالاستحقاق. يظن فيه الفرد أنه وأبناءه مسؤولية يجب على آخرين أن يتكفلوا بها، وينفقوا عليها.
المجتمعات ذات الثقافات الرسالية تعنى كثيرًا بموضوع إلى من ينتسب الفضل. الحاكم يريد أن يكون الموجه الوحيد. المثقفون يريدون أن يكونوا نقطة المرجعية. كلاهما يريد أن يعود إلى أزمان سابقة كانت فيه دعوة فكرية يتوفر لها عدد جيد من العضلات قادرة على إسقاط حضارات وإعلاء أخرى.
هذه المجتمعات القديمة تحصر نفسها في نقطة الصراع، وتمررها ثقافيًا إلى الجمهور.
لكن الثقافة السياسية الحديثة لم تبن على هذا. لقد بنيت على تنامي الثروة، وفض الاشتباك بينها وبين “أهل الكتاب”.
الحريات بدأت بالحريات الاقتصادية التي تحتاجها مهنة التجارة، وبتراكم أرباح التجارة ظهرت طبقات جديدة تملك المال، بعد أن كان هذا مقتصرًا على الملك والإقطاع/ النبلاء من حوله، وعليهم أيضًا اقتصرت القدرة على نشر الأفكار والفنون.
الآن صار هناك ممولون آخرون، مستقلون. وخطوة وراء خطوة صار هؤلاء مراكز قوى متناثرة لا تستطيع سلطة مركزية أن تتحكم فيها وفي قراراتها. صار هؤلاء قادرين وراغبين في المخاطرة بأموالهم مع الأفكار والتجارب العلمية الجديدة، وتمويل الرحلات الاستكشافية بغرض التجارة والمعرفة العلمية. لقد أدرك هؤلاء الثروة الكامنة في المعرفة.
بتعاظم نفوذ هذه الشرائح الجديدة صارت مركز ثقل سياسي أيضًا، وصار لزامًا البحث عن طريقة لإشراكهم في السلطة. فتطورت الديمقراطية.
لقد قاد ربحهم إلى ربح مجتمعاتهم. لقد أفادوا أهل الأفكار، وأفادوا السلطة السياسية برفع مستوى معيشة الجمهور.
اتركوا الأرباح في يد من أثبتوا أنهم قادرون على إدارة المال. شجعوهم أن يخاطروا، وأن يفتحوا مزيدًا من المشروعات، ويوظفوا مزيدًا من العاملين، ويراكموا في أيديهم خبرات جديدة في مجالات جديدة، ويدفعوا للعاملين لديهم رواتب وضرائب وتأمينات، ويخلقوا ما تحتاج إليه المجتمعات أكثر من غيره: قيم العمل.
 موضوعات متعلقة
موضوعات متعلقة