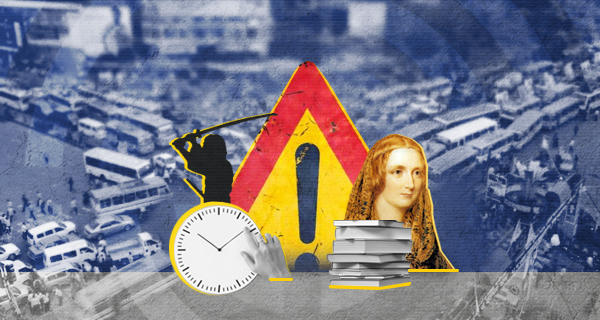
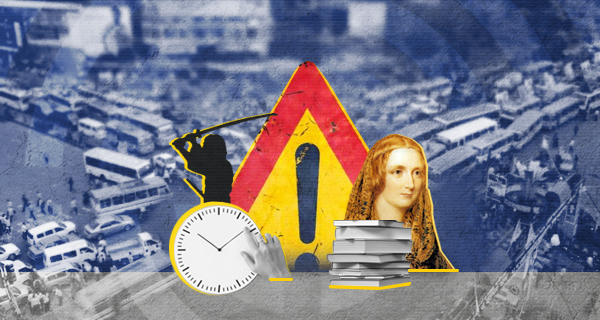
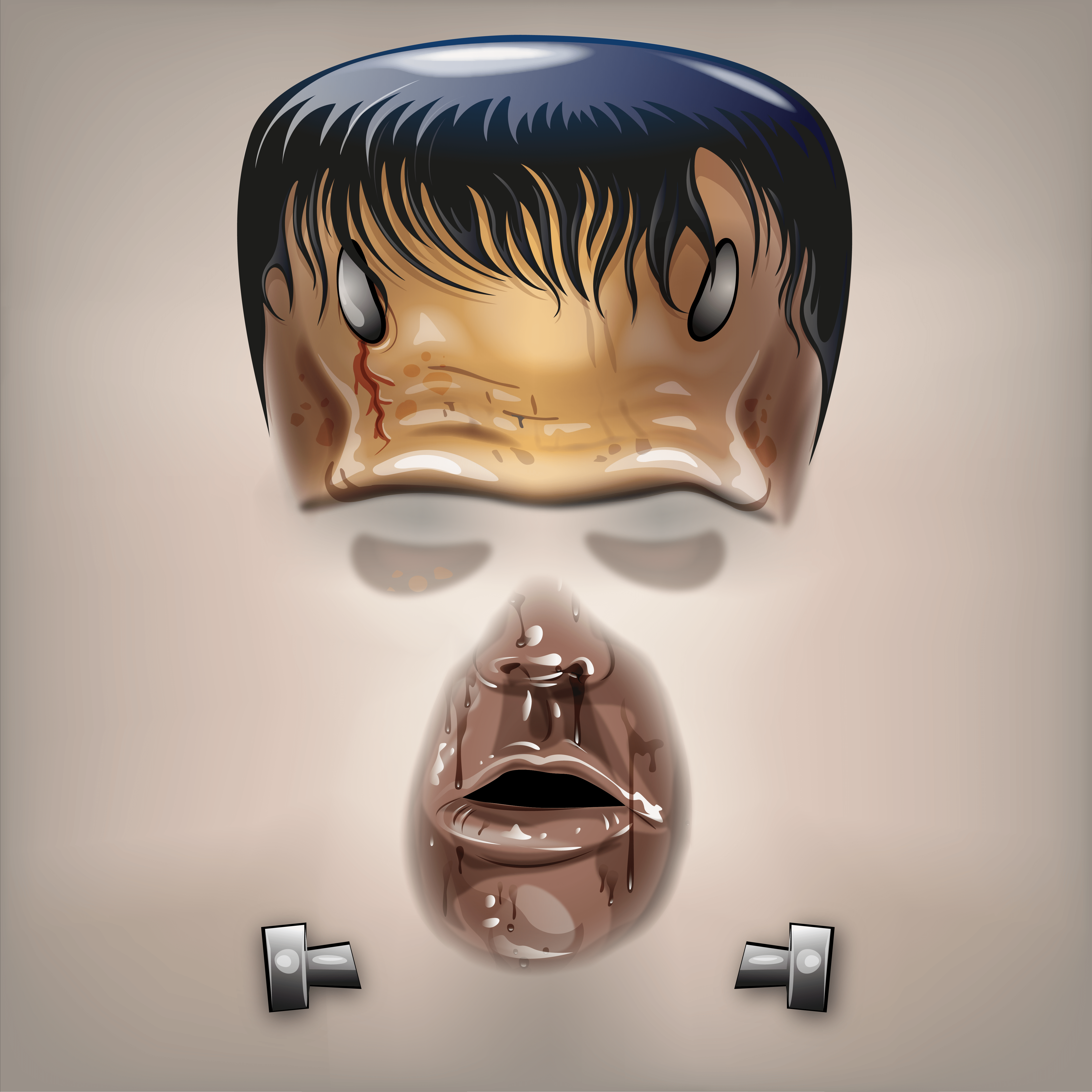
نُشرت رواية فرانكنشتاين في اليوم الأول من سنة ١٨١٨. رواية مذهلة بكل المقاييس. لن أحتاج إلى التذكير بمن هو فرانكنشتاين، الرواية دخلت في الذاكرة الشعبية للعالم بأسره، وصار فرانكنشتاين مفردة تساوي حكاية كاملة. من لم يقرأ الرواية رأى الفيلم، ومن لم ير الفيلم رأى أعمالًا مقتبسة منه، أو حتى سمع الكلمة في حوار عارض وفهم غرضها ومغزاها.
في هذه الرواية، فرانكنشتاين، ٣ أطنان إبداع ومعرفة وموهبة وابتكار، مودعة بين غلافي كتاب منسوب إلى “المؤلف”.
من؟!
المؤلف.
من هو؟ لماذا لا يعلن عن نفسه؟
لأن المؤلف امرأة.
ماري شيلي لم تكتف بحبها الجارف للعلوم، واعتنائها بإجراء تجارب في معمل منزلي، بل كانت مطلعة على الاختراعات والابتكارات، وهذا موضوع منفصل عن العلوم، وإن وضعه بعضنا في سلة واحدة.
الابتكار قد يكون مبنيًا على فكرة قديمة، كل الناس تعرفها، لكن المبدع استطاع أن يوظفها توظيفًا لم يسبق لغيره فعله. الابتكار، من ثم، ينتمي إلى الفنون أكثر مما ينتمي إلى العلوم. ستجد أن أصحاب الابتكارات – غالبًا – ليسوا في الصف الأول من العلماء النظريين، لكن لديهم ما لا يقل تفردًا.
شيلي، الفنانة، محبة الأدب، أحبت العلوم وأحبت الابتكارات، ثم عبرت عن هذا في مجال ثالث لا ينتمي إلى أيهما. تكاد تكون ابتكرت نوعًا جديدًا من الأدب اسمه الخيال العلمي، أو على الأقل أخذته إلى مستوى غير مسبوق. وضمنته ما يتضمن الأدب من رؤية وفلسفة وتعلق وإثارة.
الزمن الذي نشرت فيه الرواية ليس تاريخًا سحيقًا. يفصل بيننا وبينه مجرد قرنين. في هذا الوقت كانت بريطانيا قد أنجبت بالفعل ويليام شكسبير قبل قرنين. إسحق نيوتن، وجون لوك، وفرانسيس بيكون منذ قرن ونصف. ديفيد هيوم في الفلسفة، وآدم سميث في الاقتصاد، منذ نصف قرن.
كان توماس نيوكومن قد طور محرك البخار، وجيمس وات أدخل عليه تعديلات سمحت بتداوله تجاريًا. كان لدينا شجرة الكائنات، مفصلة وموزعة حسب الأنواع والفصائل، وعرفنا كثيرًا عن طبقات الأرض والتكيف والتحور والكائنات المنقرضة. كانت بريطانيا على وشك تقديم الرجل الثاني الذي ستغير أفكاره العالم بعد ما فعل نيوتن – تشارلز دارون.
تصنيعيًا، فكريًا، علميًا، فلسفيًا، اقتصاديًا.. قدمت بريطانيا أعمدة حياتنا حتى الآن. كل هذا وماري شيلي لم تكن بعد قادرة على كتابة اسمها على رواية!
كل هذا وسوف تنتظر المرأة البريطانية (وكثير من الرجال) قرنًا آخر لكي تحصل على حق إبداء رأيها بالتصويت في الانتخابات!!
هل يعني هذا لنا شيئًا؟
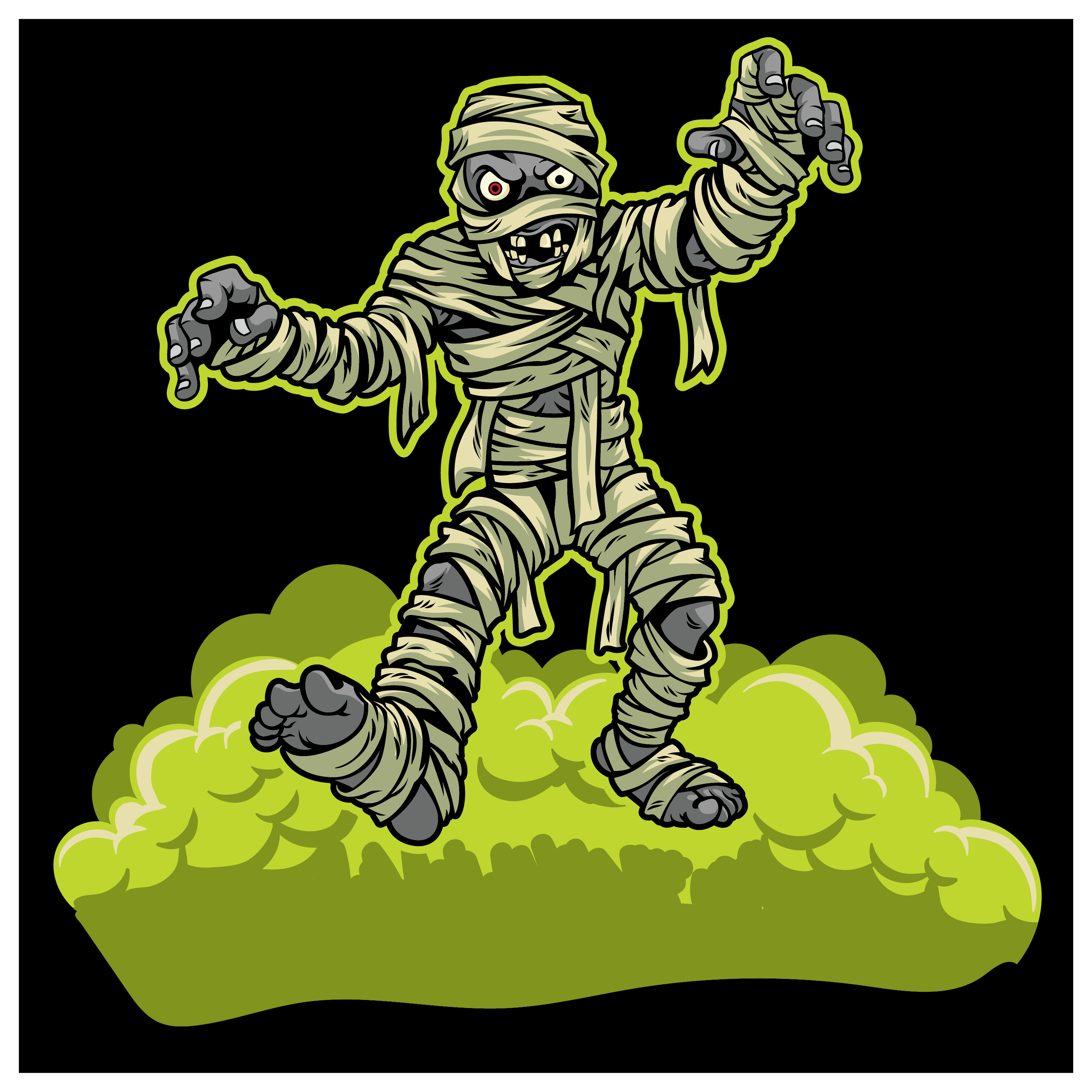
بدأت كتابة هذا المقال وأنا أشاهد فيلمًا عن ماري شيلي، في الطائرة، وهي اختراع ظهر في القرن التالي لظهور روايتها، وبعد قرنين ونصف من نيوتن.
أية دولة في العالم، بغض النظر عن مستواها العلمي، ناهيك عن تطورها المجتمعي، لديها طائرة. حتى لو لم تقدم طوال تاريخها الحديث ولو شخصًا واحدًا في مكانة ما قدمته بريطانيا. حتى لو كانت لا تستطيع حتى الآن صناعة طائرة، مع توافر العلم النظري، والخامات، والإمكانات المالية الكفيلة بالتصنيع.
حيازة منتجات التقدم التكنولوجي يجعل النخبة في المجتمعات المتخلفة تقول لنفسها: ماذا ينقصنا؟! لماذا لا نكون مثلهم؟ ألسنا نستخدم الكمبيوتر كما يستخدمون، ونخرج أطباء كما يخرجون، ولدينا قمر صناعي كما لديهم؟ ألسنا نطلع على المعلومات على الإنترنت؟ ألا نركب طائرات، ونشتري نظارات الواقع الافتراضي، ونتطبب بالمضادات الحيوية، ونخلع أسناننا تحت تأثير البنج؟!
ربما لا تقول هذا بشكل مباشر. ففي الطريق بين العقل واللسان ضمير، حتى في أقل النخب ضميرًا، ولو من باب البريستيج. من السهل أن نرد على هذا الشخص “النخبة” بإجابة بسيطة: ينقصنا أن ننتج في الفكر البشري كما أنتجوا. ينقصنا أن نغير قيم المجتمع وعلاقاته كما غيروا. ينقصنا أن نواجه مسببات التخلف كما فعلوا.
المقارنة أصلًا حرام. ألا ترى السيف يصغر قدره إن قيل هو أمضى من العصا!
لكننا نسمع المقولة بين ثنيات الكلام، ونراها بين سطور مقالاتهم، ملتحفة ببرستيج العُلا الاخلاقي، نائمًا في السرير بدلًا من المطلوب، المنطق الصحيح، الهادي عن الضلال، المخرج من الظلمات إلى النور. نعرفها في لحن أقوالهم، بيبنما يظنون أن الشعارات التي يعلقونها فوق رؤوسهم تطهرهم بالماء والثلج والبرد، وتحجز أقلامنا عن قاصر الأفكار منهم.
أبدًا. فلا عذر لهم. مشهد بسيط في فيلم ماري شيلي، ومكرر في آلاف غيره من نفس الحقبة، كافٍ لمن أصغى السمع والتفكير وهو يشاهد.

في فيلم ماري شيلي وغيره من أفلام تلك الحقبة، ستلاحظ أن شوارع لندن لم تكن نظيفة، وليس هناك إشارات سير ولا أرصفة. بل تتداخل العربات التي تجرها الحيوانات مع البشر، ويتشارك الجميع الطرقات. هذا في لندن، عاصمة الإمبراطورية التي توشك ألا تغيب عنها الشمس.
لندن، عاصمة الإمبراطورية، لم تكن تختلف كثيرًا عن الريف:
صحيح أن سكانها المتجاورين غرباء، لا تجمعهم قرابة عائلية، على طبع السيتي.
صحيح أن مهن ساكنيها لا تتعلق بالزراعة ورعاية الماشية، بل لا تتعلق بأي مهنة واحدة، على طبع السيتي.
صحيح أن كثافتها السكانية أعلى كثيرًا من الريف، على طبع السيتي.
لكنها حديثة العهد في أغلب جوانبها. وبالتالي فإن معمار الحضر لم يستقل تمامًا. لم يكن الرصيف تحول إلى علامة أساسية فيه. لم تكن هناك حاجة.
هذا التطور الطبيعي.
الإنسان لا ينتقل من الطفولة إلى الشباب بين يوم وليلة. سيكون هذا مفزعًا للغاية: طفلك نام ليلة أمس في حضنك، يلهو ويتنغنغ، واليوم صار رجلًا بشارب، أو امرأة تحمل طفلًا على يدها. لن ينتقل أيهما أيضًا من هذا إلى الشيب في لحظة. لن يحدث هذا إلا لرجل اختطف حبيبته فاكتشف أنه اختطف حماته، مثل توفيق الدقن.
في ذلك الوقت في الغرب أيضًا، ورغم كل التقدم العلمي والفكري، لم تكن بعدُ موجودةً القوانين التي تحمي الضعفاء، وتساوي بين المواطنين على اختلاف أعراقهم وأنواعهم ودياناتهم.
بعد ماري شيلي بأكثر من نصف قرن، حبس كاتب موهوب آخر، أوسكار وايلد، بسبب ميوله الجنسية. بل بعدها بقرن، سجن أيضًا آلان تورين الذي يقال إنه أنقذ ملايين الأشخاص بسبب دوره في حل الشفرة التي كانت ألمانيا تستخدمها في الحرب العالمية الثانية، وأسس للكمبيوتر. حبس هو الآخر بسبب ميوله الجنسية. الآن، في المجتمعات الغربية.
صار مجرد السخرية من المثلية الجنسية تكلفك غاليًا
أمريكا ستنتظر قرابة المئتي عام بعد حرب تحرير العبيد لكي تعطي ذوي البشرة السوداء حقوقًا اجتماعية متساوية. الآن صار موضوع الأعراق أرض ألغام من الأفضل لك ألا تقترب منه. لقد تحولت بعض الأفعال من مباحات إلى موبقات.
كل ما نراه الآن في العالم المتقدم خلفه رحلة، خلفه مشوار.
هذه الملاحظة البسيطة عن الماضي، التي أعلم أن كثيرًا منكم سيتفقون معي فيها، لها دلالة كبرى على المجتمع والفرد.
لكننا – رغم ذلك – نختلف في أحكامنا إزاء من لا يسير في مسار المسابقة، ويتخذ طريقًا مختصرًا إلى نقطة النهاية.
هل يصلح هذا المثل “الرياضي” حين نتحدث عن تطور المجتمعات. تعالوا نر مثالًا بسيطًا.

من المفيد ملاحظة العلاقات المادية في تطور المجتمعات، حيث النقاش حول أمور معنوية يدور غالبًا في الفراغ. استيراد عدد كبير من السيارات، مثلًا، وإطلاقها في شوارع ترابية، بلا أرصفة، ولا إشارات مرور، ولا علامات طريق، لن يحدِّثه.
أوك. نسفلت الشارع.
لن يحل الموضوع.
نركب إشارات مرور.
لن يحل الموضوع.
نضع علامات طريق.
لن يحل الموضوع.
هناك ما أهو أصعب من هذا. تعليم قادة السيارات معنى هذه العلامات. تعليمهم أن يفهموا علامة “أبق الموضع خاليًا” المرسومة على شكل خطوط صفراء متقاطعة ترسم معينات، ثم احترامها. تعليمهم أن يلتزموا بالحارات. تعليمهم أن يلتزموا بقواعد الأمان داخل السيارة. تعليمهم “ثقافة السيارات”.
ثم لا بد من جراجات تتجمع فيها السيارات وإلا احتلت الرصيف ونصف الشارع. ولا بد من أرصفة يفهم المجتمع كله أهميتها، وغرضها، ويحترم وظيفتها، وإلا اضطر المشاة، مرة أخرى، إلى العودة إلى الشارع.
خطوة خطوة ستجد أنك لكي تستمتع بمزايا وجود هذه الآلة الحديثة في المجتمع لا بد أن تعود – حسنًا – خطوة خطوة. ولكن إلى الوراء. حتى تكتمل المنظومة: أرضًا، وعلامات، وإشارات، وبشرًا.
ذلك أن قشرة الذهب لن تجعل الخاتم الصفيح معدنًا ثمينًا.
لاحظ أن هذا يشبه ما كان حكام المسابقات ليفعلوه لو أن متسابقًا أخذ طريقًا مختصرًا لكي يصل إلى خط النهاية قبل غيره. المسابقات، كما الحياة، ليس غرضها لمس خط النهاية. بل غرضها إثبات القدرات خلال الرحلة نفسها. إثبات حيازتك لقيم معينة: السرعة، قدرة التحمل، اللياقة البدنية، اللياقة الذهنية، القدرة على حل المشكلات، القدرة على الغطس … إلخ.
الخطوط المتقدمة في سياسة المجتمعات تشبه هذا. لمس الصندوق الانتخابي، مثلًا، ليس الغرض. المجتمعات المتقدمة وصلت إلى الصندوق الانتخابي بعد تجاوزها عراقيل معينة. منها التفرقة بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو النوع. ومنها الفكر الخرافي. ومنها سلطة غير ذوي الحيثية. كسلطة رجال الدين على السياسة. ومنها انشغالها سابقًا بقمع التنوع، بدلًا من الانشغال بالنظر إلى الأمام والشراكة.
إن أردت أن تعرف أين نحن بكل كمبيوتراتنا وسياراتنا وانتخاباتنا وحضرنا وطائراتنا وغرف عملياتنا ومضاداتنا الحيوية فما عليك إلا أن تنظر حولك، وتلاحظ.
صحيح أن لدينا سيارات حديثة، تنتمي إلى القرن العشرين وبعده، لكن – في الحقيقة – هذا هو العنصر الشاذ في شوارعنا، وليس علامة الحداثة. وهو ليس العنصر الشاذ الوحيد. نتائج التقدم الطبي عنصر شاذ آخر. الدول التي قدمت للعالم الطب الحديث منضبطة العدد. لكن الدول التي اشترت منتجات الطب الحديث، دون مشاركة في الفلسفة والقيم التي أدت إليه، لا تزال تنجب كإنسان عصر ما قبل التقدم الطبي، بينما تحافظ على من أنجبت كإنسان ما بعده.
لن يمر هذا الشذوذ أيضًا بلا أثر. السلوكيات التي كانت قديمًا محصورة في عشوائيات الحضر، بسبب الكثافة السكانية والعجز عن السيطرة القانونية، صارت الآن في قلب الحضر.
هذا واضح. لكن هناك سؤالا أكثر خفاءً؟!
لماذا يحدث هذا بالأخص في الدول التي قطعت في طريق التحديث شوطًا، ثم لسبب أو لآخر، قررت في نقطة من الزمن أن معدل “التحديث” يجب أن يسرع جدًا. ليس بزيادة الجهد. وإنما باختصار الطريق إلى نقطة النهاية. تماما كما يفعل المتسابق “المزوغ”.
لقد قررت هذه الدول أن عليها أن تدفع اللي وراها واللي قدامها لكي تسدد “خانات الحداثة”.
قررت أن تقفز إلى النهائيات، دون مشاركة في التصفيات، بل دون حتى التدرب على المشاركة في التصفيات.
لا بد أن يستطيع المئة في المئة فورًا أن يحصلوا على التعليم مجانًا، وعلى شقق الحضر بثمن بخس، وعلى الوظيفة المكتبية بإجراءات تخرج صورية، ومهارات صورية.
فعلت هذا أيضا بمساندة “نخبة دعم الفهلوة”. وهي نخبة جاهزة حاضرة في مجتمعاتنا على الدوام.
حقنا يا عم.. حقنا.. هو فيه إيه!! مش ولاد تسعة كلنا ولا إيه!!!
نعم. تبدو الجملة السابقة منتزعة من خناقة شارع. لكنها في الحقيقة ملخص ما تطرحه نخبة تلك المجتمعات من أفكار، كلما عرض لها سؤال اجتماعي سياسي. الكارثة أن هذا صار شعورًا شعبيًا، يعطل التطور. ووعد: المثال القادم هو المثال الأخير.

حين نفهم ما حدث في المجتمع البريطاني، وغيره من المجتمعات الغربية. حين نرى فعل الشيوعيين في مجتمعاتهم. بل حين نرى ما حدث في دول كمصر وسوريا والعراق والجزائر. نستطيع أن نلخص المشكلة: الاستعجال على النهايات.
بل قرون قليلة، كان المجتمع الشرق أوسطي – مثلًا – لا يدري بما يحدث في فرنسا وبريطانيا. لا يشعر بمدى فداحة تأخره. ولا ما فعله العثمانيون في بلاده.
حتى داخل المجتمع نفسه، لم يكن ابن البلد المصري – مثلًا – مطلعًا على معيشة المحتل المملوكي أو العثماني الذي يعيش في القاهرة. كان يتمنى الستر. ثم كانت الصدمة مع الحملة الفرنسية.
لاحقًا. مع السينما، ومع التطور في النقل والمواصلات، صار كل مواطن فرد قادرًا على رؤية المدى الذي فاته. ولا أقصد هنا الفارق بينه وبين “الإقطاعي”. بل حتى الفارق بينه وبين ابن نفس النجع أو العزبة الذي انتقل إلى الحضر، وصار قادرًا على “أكل الطعمية المقلية الساخنة”، أو العيش الفينو، كما صار يحمل لقب “أفندي”. يا قوة الله!!
من التجربة الشخصية، استلهم “محدثو التعليم” التجربة الاجتماعية. حولوا رغباتهم (المشروعة) في ترقية حالهم إلى فعل ساذج يؤخر الجميع. لماذا؟
لأنهم لم يشاهدوا فيلم ماري شيلي. لم يفهموا التاريخ، وطريقة حركة المجتمعات.
اعتقدوا أنهم أتوا بما لم تستطعه الأوائل. سنضع المجتمع في نبلة، نسحب الوتر. هوووووب. سينطلق المجتمع كالسهم ويصل إلى خط النهاية. وسيقف العالم مشدوها. ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد الفهلوة وحدي. ويغنون لـ “جمال الثورة”.
لكن الحياة حكم نزيه. سليم المنطق. أعاد المجتمع الفهلوي مرة أخرى إلى الوراء. ولم يبال بشكواه من “ظلم الآخرين”، ولا بالتهديد بأن العالم سوف “يتلقى وعده”.
سيارات بلا قيمها لن تكون أكثر من فرانكنشتاين، آلة قتل في الشوارع. ديمقراطية بلا قيمها، لن تكون أكثر من فرانكنشتاين، تعطي الميت قشرة المعاصرة، وتمنح الإرهاب قشرة المشروعية. أما تسمية أي من هذا الحمق “ثورة” فمفيد لدى الجماهير، لكنه لا يعني لـ الحياة شيئًا على الإطلاق. كأنك سميت ما فعلت زيزي أو سعدية أو كنافة أو كشري. الحياة – لعلمك – مش بتتكلم عربي ولا حتى إنجليزي!!
 موضوعات متعلقة
موضوعات متعلقة