


المجتمعات، وهي تنتقل من الأمية إلى الكتابية، تعاني من ندرة محاضري المواد العلمية والعملية. هذا طبيعي. التطور العملي والعلمي يحدث بعد فترة من تراكم المهارات العملية والخبرات العلمية.
هذا على المستوى الوطني، لكن ميل الجيل الأول من المتعلمين في العائلة – على المستوى الفردي – إلى الدراسة النظرية دون العملية ثابت إحصائيا، انظر حولك إلى عائلتك وأقاربك، وإلى مجتمعك بشكل عام. السبب الأوضح أن دراسة المادة النظرية أبسط، وأقل تكلفة، و”تؤدي الغرض”.
فهل هذه مشكلة ثانوية؟
إطلاقًا. إنها واحدة من أسئلة السياسة الخداعة “المراوغة”. تلك التي دورُها في امتحان القادة السياسيين كشفُ المحترفين من الهواة، فأثرها الاقتصادي تراكمي، ولا أبالغ إن قلت إنه مدمر. بداية:
هذا يعني أن عددًا معينا من الأشخاص تعطلوا عن الإنتاج لمدة طويلة، كانوا فيها – تعريفًا – أشخاصًا مستهلكين. دخلوا ضمن حساب التكاليف.
بعد هذا النفق الطويل من الاستهلاك سيكون بيدهم مهارة لا تمثل أولوية اقتصادية. لم يختاروا المهنة حسب الحاجة الاقتصادية، بل حسب المتاح في النظام التعليمي.
بالإضافة إلى ذلك، لقد فقدنا هذا الشخص كقوة عاملة؛ أي فقدناه في حساب الإنتاج.
كل ما سبق في الأحوال الطبيعية. أعداد متدرجة تختار أن تسير في سلك التعليم بدلًا من الدخول في سلك العمل. في هذه الأحوال نستطيع أن نتحكم في الأثر الاقتصادي.
أما لو كانت القفزة فجائية. طفرة مجتمعية لم يكن لها ما يسبقها من طفرة في الإنتاج والثروة، فهنا ستخرب المعادلة الاقتصادية تمامًا. ثم، بعد التخرج، ستخرب معادلة سوق الوظائف. سيتوفر لدينا عدد كبير ممن لا نحتاجه، إما أن يعانوا من البطالة. أو – وهذا أسوأ اقتصاديًا – البطالة المقنعة المدفوعة الأجر، ليضاف هذا إلى كل ما سبق.

يمكن لنا بسهولة أيضًا أن نلاحظ أن المجتمعات المتقدمة، كالبريطاني والألماني والأمريكي، تطورت تدريجيًا في خطواتها نحو التعليم، وأنه على خلاف الشائع، لم يكن تطورها بسبب هذا التعليم، بل قامت ثورتها الصناعية على أيدي صناع مهرة، وأيدٍ عاملة تستجيب لحاجة العمل ومهاراته في كل قطاع ناشئ، واستثمار يخاطر في تلك القطاعات. بالنسبة لمعظم الدول المتقدمة، لا يزال التعليم الجامعي مكلفًا، بالإضافة إلى أنه محدود العدد ولو كان مجانيًا. نسبة المتعلمين تعليمًا عاليًا في ألمانيا من بين الشباب في سن الجامعة كانت ٨ إلى ١٠٪ في الستينيات.
بتعبير آخر، نستطيع أن نقول إن ١٠ فقط من كل ١٠٠ من الشباب في سن الجامعة خارج سوق العمل، وضمن سوق الاستهلاك الدراسي.
لقد علمت المجتمعات المتطورة الحقيقة الاقتصادية البسيطة: بعض التعليم لازم للتطور، وبعضه يبطئ التطور، وبعضه قد يقلب عجلة التطور فيعود بالبلد إلى الخلف. فائدة التعليم لا تتناسب طرديًا مع عدد سنواته.
من الذي يحدد هذا؟
حركة السوق.
دراستك للأدب في الجامعة، مثلًا، قرار شخصي يعتمد على رؤيتك للسوق ولقدراتك الإنتاجية. ربما تكون صاحب موهبة أدبية تريد أن تنميها بالدراسة. ربما ترى أن هناك سوقًا لتدريس الأدب، أو الكتابة في النقد الأدبي. المهم أن القرار يعود إليك. أنت تنفق عليه، من مالك ووقتك، وأنت تربح من ورائه. أو تخسر.
فضلًا عن الوقت الضائع، والأموال المهدرة بلا طائل، والقوة الإنتاجية المعطلة، فبسبب الشهادة الجامعية يعتقد كثير من الخريجين أن بعض المهن، وهي المناسبة تمامًا لمهاراتهم في سوق حر، ليست من مستواهم.
وليس ما سبق أكثر من نظرة سطحية رقمية إلى المجتمع، لكن حين ندخل إلى الفرد نفسه سنكتشف ما هو أكثر.
هذا الشخص يحمل شهادة جامعية، وهذه هي الكارثة بعينها.

في الجيل الأول من المتعلمين، المهارة الأساسية البارزة هي القدرة على نقش الحروف والقدرة على القراءة. الشخص ليس تجسيدًا لما درس في مجال التخصص، وإلا لصرت أينشتين بعد دراسة نظرية النسبية. جانب كبير من المعارف التي يتلقاها الشخص – حتى الجامعي المتعلم – تأتي من المجتمع الذي حوله. الألماني المولود في الخمسينيات من القرن العشرين، سيتأثر بالشائع في ثقافة المجتمع الألماني في ذلك العصر، إلى جانب ما درسه.
الفرد المتعلم الناشئ في مجتمع أمي التفكير، وهذا حال الجيل الأول من المتعلمين، سيكون متعلمًا أميًا، “محدث تعليم”، كما الفرد حين ينتقل إلى أي حال اجتماعي جديد. التغير الأسهل يكون في الظاهر، أما التغير الجوهري فيحتاج إلى أجيال لكي يحدث. لا يتعلق هذا بقدح في الشخص عينه، لكننا جميعًا نميل إلى اكتساب الأسهل فالأصعب.
ربما يخرج هذا الشخص من دراسته الجامعية عالم ذرة، لكنه متعصب ضد جيرانه. ربما يكون طبيبًا، لكنه لا يثق بالمراة. ربما تكون مهندسة، لكنها تعتقد أن دهان حلاق الصحة أفضل من وصفة طبيب العيون. ربما خريجة فنون جميلة، لكنها تعتقد أن الفن يجلب النحس للاقتصاد. يحيى حقي تناول هذا في “قنديل أم هاشم”، ونحن الآن، بعد عقود، لا نزال نرى كثيرًا منه. أعرف أطباء نفسيين مقتنعين أن المرض العقلي مس من الجن، وتعرف بالتأكيد أساتذة جامعيين يتبادلون مع زملائهم مجاملة أبنائهم على حساب بقية الطلاب. دون الانتباه إلى أن هذا جريمة غش.
في كل واحد فينا ما يصعب تغييره بالتعليم وحده.
حين يحمل هذا الفرد شهادة جامعية في يده سيستخدم مهارة فك الخط ونقش الحرف لتأكيد معارفه الأمية، محملًا بين دائرته بقوة معنوية كبرى.
في الجيل الأول من المتعلمين في العائلة، إلى جانب المنفعة، خطر فكري يجب الانتباه إليه.
لكنه ليس الخطر الوحيد. نفسيته أيضًا فيها خطر.



الإحساس بالسعادة أو الغنى نسبي، يتحدد حسب مقارنتك لوضعك مع الدائرة المحيطة بك.
هكذا أيضًا الإحساس بالمعرفة.
الجيل الأول من المتعلمين، المحاط بعائلة أمية، ومجتمع أمي، يعتقد بلا جريرة منه أنه أوتي من العلم مبلغًا. مَن حوله يعمقون لديه هذا الإحساس. فلان أفندي جاء فلان أفندي راح.
هذا يعطيه عن نفسه قيمة غير حقيقية، مبالغًا فيها، يظن أنه بما حاز من “مهارة” التعليم جدير بأن يلقى تقديرًا تلقائيًا، بغض النظر عن حاجة السوق الفعلية، وحجم ما يستطيع – عمليًا – أن يقدمه. كيف لا وهو الشخص الذي اقتاتت الأسرة والمجتمع لكي تصل به إلى ما وصل. وكيف لا وهو الشخص الذي قضى ١٦ عامًا من عمره يذهب إلى المؤسسة التعليمية صباحًا ويعود في آخر النهار. وهو الوحيد في العائلة القادر على قراءة الجريدة، والتمعن في العقود، وربما يجري محادثة باللغة الإنجليزية.
يعتقد أنه مستحق لأن نخلق له مهمة جديرة بقدراته.
لو كان سوق العمل أضيق من عدد الخريجين سيكون هذا مستحيلًا.
ينقم.
لكنه يحتفظ بقدر خاص من النقمة نحو الناجحين بغير المسلك التعليمي، يعتبر أن ثراءهم دليل على أن الوضع مقلوب. “انتبهوا أيها السادة” عنوان الفيلم الذي صدر في مصر عن حكاية “الزبال المليونير”. كيف يكون جامع القمامة أفضل منه حالًا. كيف!
هذا الشخص الجامعي – انظر حولك – ربما يلقي القمامة بيده في الشارع دون وخزة ضمير.
لكن لا يفهم أن جامع القمامة، أو سائق التاكسي، أو البقال، أكثر نفعا للمجتمع.
لن يدرك أخونا وأختنا ممن قضوا أعمارهم في الدراسة أن البزنس مؤسسة مستقلة. أن شخصًا يمتلك من الذكاء والملاحظة والشجاعة وحب المخاطرة ما يمكنه من التعامل، والاستثمار، والتواصل مع أنواع مختلفة من البشر، وإدارة علاقاتهم معهم، والاستعداد للتنقل والسفر، والقدرة النفسية على احتمال المخاطرة. أن هذا الشخص، طباخًا كان أم تاجرة أم مقاولًا أو سمسارة، ولو كان أميا، يملك من المهارات أكثر منه بكثير. والأهم، الأهم، يملك مهارات يحتاجها السوق. لأن هذا هو المعيار.
البزنس، لا يدرك خريج المدارس، قد يفشل فيه خبير اقتصادي حائز على ٣ دكتوراه، إحداها في إدارة الأعمال.
البزنس هو نغمة السوق، وفيديو جيم الحياة.
لكن خريج الجامعة يملك مهارة الجدل، ويتسابق عدد لا بأس به منهم على العمل في مجالات الرقابة المعنوية، ومن بينها الإعلام.
هنا، سيكرس حياته لإثبات الارتباط بين الغنى واللصوصية، سيحول عبارة “بزنس مان” أو “سيدة أعمال” إلى عبارة مثيرة للريبة في أقل تقدير، أو مستحلة الاستهداف – بضمير.
ما تعلم من منطق لن يكفيه لكي يعاتب نفسه إن اختار نماذج استثنائية ليعممها على شريحة كبيرة من المستقلين المخاطرين، مشغلي اليد العاملة، الذين يضعون ثرواتهم على المحك جريًا وراء أفكارهم.
سيحدثنا كثيرًا عن أحلامه غير المختبرة.
سينسب التطور إلى نفسه. سيروج أن العالم تطور لأن عددًا أكبر من خريجي الجامعات تخرجوا. لا يدري أن العالم تطور بالعمل فصار لديه من الرخاء ما يمكنه من بناء مزيد من معاهد التعليم، وليس العكس. وفتح الاستثمارات لاستيعاب خريجيها وغيرهم.
لا يدري أن التجارة والكشوف الجغرافية مسؤولة عن تطورنا أكثر كثيرًا من الكتب، الأخيرة تصاغ لبلورة أفكار الأولى. أن مخترع الطائرة، والمصباح الكهربائي، وغيرهما، لم يحظوا بنصيب من التعليم، لكنهم حظوا بكثير من المعرفة والملاحظة والذكاء والشجاعة.
وسيجعلنا هؤلاء الجامعيون نبحث عن التطور في الاتجاه الخطأ. ولا سيما لو كان الرأي النافذ في المجتمع هو رأي هذا الجيل الأول من المتعلمين.
ما سبق ينطبق على كل المجتمعات. لم تتدخل الحكومات بسياساتها بعد. لكن إجراءين بالتحديد ستتخذهما بعض الحكومات يجعلان المشكلة تتضاعف لتهدد بقاء المجتمع ورخاءه. ويضيعان الحس الاقتصادي الشخصي لدى المواطن المتعلم. بمعنى آخر، تضيعان شخصية المجتمع.
ما الحس الاقتصادي الشخصي!
وما الإجراءان؟

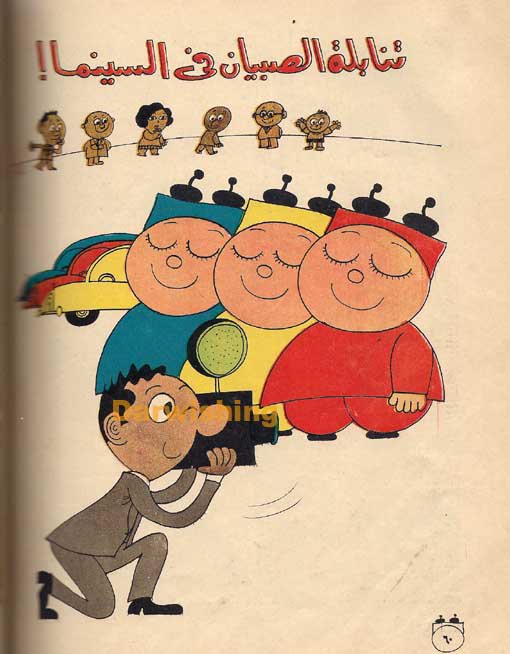
ما تقدم من أخطار بسبب الجيل الأول من المتعلمين في العائلة يمكن للمجتمع أن يتعامل معها، طالما كانوا قلة في المجتمع، بينما الأغلبية الكاسحة متحملة مسؤولية الإنفاق عن طريق تنمية مهارات عملية يحتاجها المجتمع في انتقاله الاقتصادي.
لكن كثيرًا من الدول التي أرادت التحول بقفزة راديكالية من مجتمع قديم في علاقاته الاقتصادية إلى مجتمع حديث لم تفعل هذا. في الحقيقة لقد فعلت العكس تمامًا.
أولًا: توسعت بشدة في عدد المتعلمين ممن كانوا الجيل الأول في عائلاتهم، بمعدل لم يستعد له سوق العمل، وبالتالي وزعت المهارات بشكل غير متناسب. فسحبت من السوق المهارات اليدوية والحرفية التي تحتاجها البلاد في فترات التحول، وضخت فيه مهارات أكاديمية لا يحتاجها.
ثانيًا: بتزايد هذه الفئة في العدد تزايدًا ضخمًا كونت جماعة نفوذ فكري، تتحرك جميعها بمعارفها الأمية، مدعومة بسلطتها المعنوية. صارت جماعة نفوذ حتى وسط أقرانهم من الجامعيين الذين يبدون قدرًا أقل من الميل نحو أمية التفكير، وإن لم يكونوا محصنين تمامًا. وبالتالي كسب هؤلاء المتعلمون الأميون كل يوم أرضًا جديدة، اتنشرت بعد ذلك من الجامعة لتدرس للجيل الجديد. مصر قرنت هذا بإجراء آخر فاقم من أثره. توسعت في التعليم الأزهري، وأضافت إليه العلوم الحديثة. فكأن ساستها صنعوا بأيديهم كتلة إضافية مقصودة من المتعلمين الأميين.
لكن مخطئ من يظن أني أشير هنا إلى الأفكار الدينية فقط. التوسع في التعليم العلمي لفئة واحدة من المواطنين – المسلمين – تعبير عن أفكار أمية سياسية.
أبناء أساتذة الجامعات، الذين ورثوا مهنة آبائهم بالغش، صاروا هم أنفسهم يعلمون أجيالا جديدة. وربما في الوقت نفسه يحاضرونهم عن السياسة والأخلاق، والنزاهة في المجتمعات الغربية.
ثالثًا: دون الاستعداد بالمتطلبات اللوجستية والبشرية اللازمة لتخريج جيل من المتعلمين، كان هذا كارثة على مستوى التعليم. كما كان كارثة على حظوظ الناس في سوق العمل. اختلط الرديء بالجيد. في ظل المنافسة كان لا بد من عوامل تفضيلية، فاستبدلت بالجدارة الواسطة، التي سماها المتضرر كوسة، وسماها المستفيد “خدمة”. ودعمتها الثقافة القديمة بـ “الأقربون أولى بالمعروف”.
رابعًا: وهذا الأخطر. مجانية التعليم أرسلت رسالة عكسية إلى المتعلمين. تقول لهم إن التعليم الجامعي مهم للغاية، لدرجة أننا سندفع تكاليفه كلها، وما عليك إلا أن تتفضل وتتعلم. هذا الإعداد النفسي عمق الصدمة بعد ١٦ سنة في التعليم.
خامسًا: ألزمت حكومات أنفسها بتعيين الخريجين. مع سوق لا تستوعب ولا تحتاج العدد، كان حتمًا أن يؤدي هذا إلى بطالة مقنعة، لكن أثره الأسوأ كان في صناعة الشخصية.
نعم. شخصية الفرد، ثم شخصية المجتمع، انهارت. سأذكركم الآن بحكاية تاريخية نعتقد، مخطئين، أنها ذهبت إلى حال سبيلها.
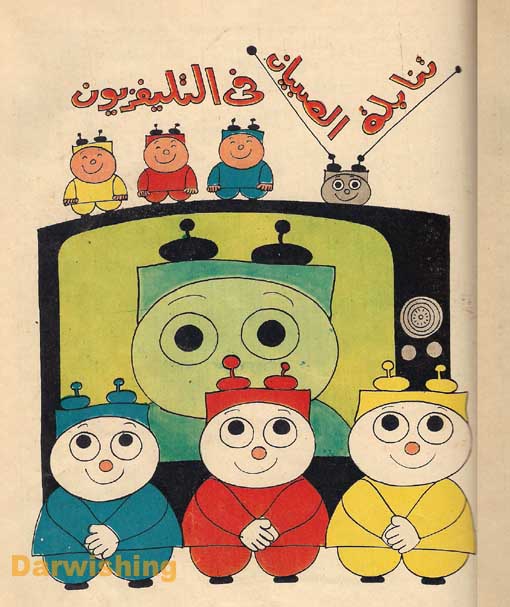
تقول الحكاية التاريخية أن خليفة عباسيا أنشأ دارا لإيواء العاجزين عن الكسب، ليقدم لهم ما يقوتهم. لكن الحكاية انتشرت.
فوجد بعض الكسالى في المستوى المعيشي البسيط الذي يقدمه الدار ما يغريهم، ويكفيهم، ويملأ وعاء طموحهم.
وانتشرت الأخبار الجديدة. صارت دار الإيواء مرتعا لقليل من العاجزين، وجنة للقادرين الكسالى. حين سمع السلطان غضب، فأمر بجمع هؤلاء وإلقائهم في النهر.

يربط بعضنا التدليل بمستوى المعيشة.
يعتقد أن التدليل – مثلًا – مرتبط بالغنى والوفرة. إذ كيف يكون الفقير مدللًا وهو يعيش على الكفاف!!
لكن التدليل أوثق ارتباطًا بسؤال المسؤولية. القانع بالقليل فقير، لكنه مدلل إن كان هذا القليل آتيا لا محالة. هو محروم فقط من الأمل والقلق، عماد تكوين نفسية الطموح، والإنجاز، والثقة المبنية عليه.
لم يختبر هذا، أبدًا، العلاقة بين الفعل والعاقبة.
عاش حياته رضيعًا موضوعًا في سلة قش، قد يجرفه التيار إلى منحدر فيموت، أو إلى بر فينجو. بلا جريرة ولا فضل. ولا اختبار للقدرة، ولا تنمية لصلابة العود، ومرونة القيام بعد الانكسار. “خليها على الله”، سيحيل قصور الإرادة إلى تفسير إيجابي. كأنه النبي موسى عين الله ذاته ترعاه.
الحس الاقتصادي ليس القدرة على إدارة نفقاتك. الإنسان، أي إنسان، يستطيع أن يعيش على أقل القليل. الحس الاقتصادي الأكثر إيجابية هو القدرة على تنمية الموارد. والمجتمع ينمو حين يسعى كل شخص فيه إلى تحسين وضعه.
الفرد المولود لأبوين ينفقان عليه، ودولة تضمن له التعليم والوظيفة، وما يبقيه على قيد الحياة من طعام وشراب، إنسان مفتقد إلى الحس الاقتصادي. حتى وإن تعلم سينصب جهده لا على الكسب، بل على انتظار الوظيفة المستحقة، على الرزق. وسيصنع دولة على شاكلته. تعتقد ويعتقد دومًا أن له في جيوب الآخرين حقًا. وسيفضل الموت نفسه على أن تطالبه بتحمل مسؤوليته.
ادلل عيني. من المهد إلى اللحد يابن المحقوقة. يا جائزة. يا كنز. يا معجزة. نحن محظوظون للغاية أننا عشنا في نفس العصر الذي عاش فيه حيوان أبيك المنوي وبويضة أمك. ولا بد أن ندفع ثمن هذا الحظ العظيم إلى الأبد.
على طريق تنابلة السلطان إلى النهر حيث حتفهم، أوقف المسيرة مستثمر ميسور، أقنع سائقها أن يمنحه فرصة الحديث معهم، قال لهم إن لديه عملا وسيعطيهم مقابله راتبا.
لكنهم رأوا العمل أقل من “مستواهم.
والراتب أقل من مستواهم.
فصرخوا في السائق .. إلى النهر .. إلى الحتف .. بل إلى الجحيم ذاته.
’الجحيم،‘ ردد رجل من المارة مستعجبا! ’هل أنتم مستعدون لتلقوا أنفسكم في نار متفجرة؟‘
ولما أجابوا نعم. قال لهم طلبكم عندي. والمقابل نعيم مقيم. اذهبوا إلى …..
وباقي القصة تعرفونها. الانتحار أهون على مجتمع الكسالى من مشقة الكسب.
