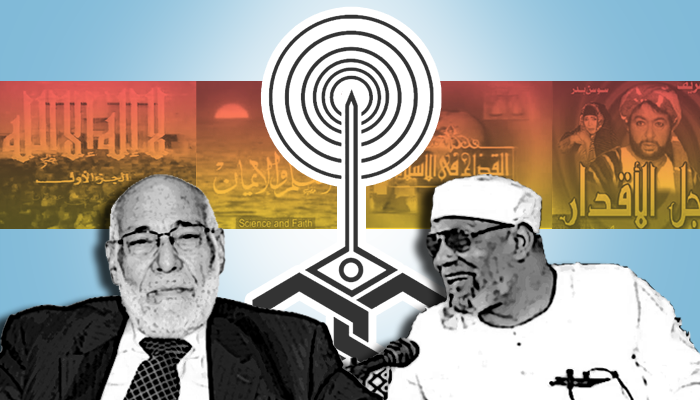
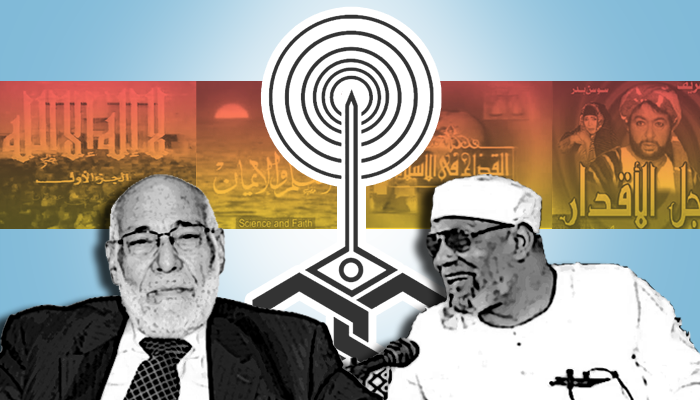
حتى منتصف القرن الخامس عشر، تشكلت القناعات والأفكار التي يتبناها مجتمع معين بعدة وسائل: تناقل تراث الأجداد، أو وجود دين رسمي يحول دور العبادة إلى مراكز لنشر خطاب ديني، أو عبر نفوذ السلطة السياسية التي تتدخل لتعميم خطابها السياسي أو الأيديولوجي.
هذه الوسائل هيمنت وحدها، وظلت وسائل التأثير فيها بعيدة عن عموم المجتمع، ومحصورة في أصحاب النفوذ السياسي، أو الديني، أو الحكواتي الذي ينقل التراث.
يتناسب هذا مع المجتمعات الأمية التي تبني قناعاتها على الثقافة السمعية دون نقاش، وهي سمة العالم كله قبل اختراع الطباعة، بما خلق تمايز طبقات القرون الوسطى “النبلاء، الإكليروس ورجال الدين، الفلاحين والتجار، وباقي المجتمع”.
لكن اختراع الطباعة أضاف وسيلتي الكتب المطبوعة، والصحافة.
صحيح أن الكتابة سبقت الطباعة بخمسة آلاف عام، لكن صعوبة انتشار المعرفة عبر المخطوطات منع تفاعل المجتمع مع المطروح الديني والفكري أيًا كان.
بانتشار الطباعة انتشرت القراءة والكتابة، وتوحدت اللغات القومية، ووصلت الأفكار دون وسيط، وفتحت الصحافة للرأي العام عبر النقاشات الفكرية.
وفي الـ 150 الأخيرة، انضمت الإذاعة، ومعها الوسائل السمعية من أسطوانات وكاسيت، إلخ، والسينما، ومعها الوسائل البصرية اللاحقة كالتلفاز والفيديو، إلخ.
في منطقتنا، تأخر تأثير الكتب والصحف لتأخر الطباعة 360 سنة، فظلت الثقافة سمعية. وهكذا أصبح الراديو في الثلثين الأولين من القرن العشرين، والتلفاز في الثلث الأخير منه، هما الأكثر تأثيرًا.
لتنحصر الوسائل الأكثر تأثيرًا في: خطاب الميديا عمومًا، والخطاب الديني عمومًا. ويمكن لأي من الخطابين تبني مواقف سياسية وفكرية مختلفة.
الخطاب الثاني تتبناه مجموعة شبه منغلقة على أفكارها وقناعاتها، تحيطها بقدسية، وتمنع الآخرين من التعاطي معها بدعوى عدم التخصص، بدرجة منع العامة من المناقشة أو التصريح علنًا بحقائق يعرفها الجميع، بدعوى أنها تثير البلبلة.
وفي ذات الوقت تسعى مجموعة “إكليروس القرون الوسطى” الجديدة باستمرار لفرض أفكارها على الجميع، كما تسعى للحفاظ على أمية المجتمع ثقافيًا بحصر أفكار ومعارف الناس داخل دهاليز خطابها، بعد خسارة معركة أمية القراءة والكتابة.
خطاب الميديا بالمقابل كان يُفترض أن يعبر عن المجتمع بشكل مفتوح؛ لأنه يصدر ويتوجه لجماعات مختلفة. لكن الواقع سار في طريق آخر بسبب قوانين تمنح الحصانة للخطاب الديني، وتواجه أي خطاب آخر بالقمع.
وحين تدخلت الدولة لتحقيق توازن مع الخطاب الديني، سيطرت على الميديا. فتأسست وزارة الإرشاد القومي في 10 نوفمبر 1952؛ لتوجيه الرأي العام، ثم أصبح اسمها الإرشاد القومي والثقافة، لتنفصل الثقافة 1965، ثم يتغير الإرشاد القومي إلى الإعلام 1970، ثم الإعلام والثقافة بين 1975 و1981، ثم الانفصال مجددًا، ثم إلغاء وزارة الإعلام بحكم دستور 2014، ثم إنشاء مجلس أعلى للإعلام، ثم إعادة وزارة الدولة للإعلام في ظروف غامضة.
هل نجحت الدولة في تطوير خطاب المشروع الوطني؟ أم أن سياسة الموائمات قادت لتراجع تأثيره؟
في أوقات كثيرة، قامت الدولة بدور من يقطع أنفه ليغيظ الآخرين بشكل أنفه المقطوع، فلا تركت من يريد طرح أفكاره لمواجهة المشاريع المنافسة، ولا واجهت المشاريع المنافسة عندما أمسكت بالدفة.
التلفزيون المصري قدم في بدايته الراحل أحمد فراج في “نور على نور” بين 1960 و1977. ومن خلاله، تحول الدكتور مصطفى محمود، والشيخ محمد متولي الشعراوي، وآخرون إلى نجوم.
سافر بعدها للخليج، وعاد في 2000 لبضع سنوات أخرى، قدم خلالها زغلول النجار بنفس الطريقة.
ما يسري على أحمد فراج يسري على مصطفى محمود في “العلم والإيمان”، وعلى خواطر الشعراوي، وغيرها. كلها اعتمدت على نجوم يحصلون على ثقة الناس، ثم يظهرون عبر تلفزيون الدولة لترويج أفكار غير صحيحة علميًا، أو خطاب بعيد عن المواطنة، يتضمن ترويجًا للكراهية أو التمييز أحيانًا.
بالتوازي، سمح الأهرام ليوسف القرضاوي بنشر ضلالاته، وأفردت مساحات لزغلول النجار لنشر تلفيقاته، ولفهمي هويدي للترويج للإخوان وإيران، ولمصطفى محمود لترويح “المؤامرة” ضد الإسلام والمسلمين، وهي أحد أركان الأساس في تضليل الناس معرفيًا وإبعادهم عن المشروع الوطني.
كل تلك البرامج أسست للإمبراطورية اللاحقة من نجوم التليفزيون وشرائط الكاسيت الدينية، الذين انطلقوا بعدها على قنوات أخرى، وساهموا في تراجع المشروع الوطني.
في النهاية، للبرامج الدينية طبيعتها. ولا أحد ينتظر اختلافًا كبيرًا في الخطاب الديني بين منبر وشاشة تلفاز، طالما أن البرنامج مجرد ناقل للفكر، وليس ناقدًا أو مفكرًا أو محللًا له.
لا يفترض أن تروج الدراما المصرية الدينية والتاريخية لأفكار معادية، ولا أن تعرض لشخصيات دون استعراض حقيقتها بأمانة، أو تمجد أفعالها العنيفة غير الملائمة للعصر.
لكن مسلسلًا مثل لا إله إلا الله (أربعة أجزاء – 1985/ 1988) لم يكتف بالرواية الدينية لقصة النبي موسى مع فرعون، فمر بربط غريب إلى تمجيد إخناتون، والانتقاص من رمسيس الثاني.
كذلك، انطلق “القضاء في الإسلام” من اسم وفكرة غريبتين؛ الاسم معناه أن القضاء في الإسلام مرتبط بفترة معينة تمثل وحدها “فترة الإسلام”، والفكرة تروج ضمنًا لاعتبار قضاء القرون الغابرة ممثلًا للعدل الغائب، وبالتالي، فمن يريد العدل عليه استعادة ذلك الزمن، في ربط متعمد لفكرة العدل القانونية السياسية الإدارية للدول وأنظمتها بالاعتقاد الديني، ثم ربط الاعتقاد بنظام سياسي تاريخي بعينه.
أجزاء المسلسل التسع روجت لنفس الفكرة بين عامي 1986 و2000، قبل استنساخها في “قضاة عظماء” على جزئين، 2016 و2019، فقط بعد النجاة من فخ الاسم.
خلال تلك السنوات، عرضت الدراما المصرية مسلسلات عن أئمة المذاهب الإسلامية، الذين ظهروا جميعًا في مرتبة التقديس، لترسخ فكرة أن الكمال ينتمي لعصر مضى، وأن عالمنا منقوص، إن أراد العودة لكماله فعليه العودة للخلف ببساطة.
زاد الأمر سوءًا في مسلسلات عمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد، وموسى بن نصير، وعقبة بن نافع، وعبد الرحمن الغافقي (بلاط الشهداء)، وطارق بن زياد (الطارق)، وخالد بن الوليد، وهلم جرًا، رغم عدم ارتباط معظم هذه الشخصيات بتاريخ مصر.
حتى “عمرو بن العاص” الذي تناول شخصية مؤثرة في التاريخ المصري، زيف التاريخ بشكل غير مقبول، بتغييبه لأحداث الفتنة الكبرى ودور ابن العاص فيها، أو عرضه لسلوكه مع المصريين، وأهدافه السياسية من دخول مصر.
وفي 2010، كان “سقوط الخلافة” الذي حمل تمجيدًا مكثفًا لعبد الحميد الثاني والعثمانيين، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والسوريين، و”القعقاع بن عمرو التميمي” الذي روج لبطولة آل تميم، الذين ينتسب إليهم آل ثاني حكام قطر.
قطر دعمت المسلسلين إنتاجيًا، بينما راجع القرضاوي مسلسل القعقاع بنفسه.
حتى الدراما المصرية الاجتماعية روجت لأفكار مماثلة يظهر معها أن دفاع مسلسل الاختيار عن فقهاء رحلوا قبل سبعة قرون، وتأسست على أفكارهم الكثير من مناهج العنف، ليست إلا حلقة في عجز الميديا المصرية منذ عقود؛ نتيجة لغياب العقل الناقد في من يقوم بالمراجعة.
بعد الحلقات بدقائق، انهمرت رسائل الدفاع عن ابن تيمية، والهجوم على إسلام بحيري “لانتقاده السابق له”، ليظهر مدى تأثير الميديا، وكيفية توجيه جماهير مغيبة لدعم أفكار بعينها.
العجز المادي قد يكون مفهومًا، لكن العجز النقدي والفكري عن المواجهة ليس مفهومًا على الإطلاق، ولا يمكن وضعه إلا في سياق أن الخصم يعرف ما يفعله، ويعرف كيف يروج لأفكاره، بينما تكتفي الدراما المصرية بالنية الطيبة، مع كثير من التردد والخوف، وكأن على رؤوسنا بطحة.
تغيير الأفكار المضرة في المجتمع لن يحدث إلا بوسائل التأثير الحديثة. لكن هذه الوسائل تحتاج إلى مفكرين حقيقيين، لا “مؤدين ومطيباتية”.
الغريب أن الدولة تريد الحفاظ على فكرة “وزارة الإرشاد القومي” بكل مساوئها، دون أن تؤدي “الوزارة” أيًا من مميزات أدوارها السابقة، لا في الإرشاد القومي، ولا الإعلام، ولا الثقافة، إلا في ما يتعلق بزيادة السيطرة على مساحات التعبير، لكنها في المقابل لا تملأ مساحات التعبير هذه بشكل مناسب.. مجرد سيطرة على موقع، وليس استغلالًا أمثل له. ورغم وجود وزارتين ومجلسين أعليين للإعلام وللثقافة، فإنها في ما يبدو إما لا تريد أن تختار أشخاصًا بمثل قدرات ثروت عكاشة أو يوسف السباعي، أو أنها لا تعرف كيف تجدهم، أو أنها لا تعرف ماذا تريد منهم، وما هو المطلوب منهم أصلًا. لتظل الدراما المصرية تحت إشراف وزارة “إرشاد نصف قومي” أو “إرشاد نصف وطني” بالأصح.
 موضوعات متعلقة
موضوعات متعلقة