لو كنت أكتب رواية لما أخبرتكم من البداية أنني أسد. لتركتكم تكتشفون بأنفسكم. ولما أخبرتكم أيضًا أن المشهد الذي سأحكيه لكم ليس أكثر من كابوس ينتابني في الأيام الأخيرة. أما وما أكتبه رواية صحفية، وقراءة الصحافة قراءة سريعة وأحيانًا كسولة، نصف مشغولة، فقد قررت أن إخباركم من البداية أفضل. وبالمرة سأخبركم أنني هارب من سيرك ولدت فيه، ولم أعلم في بداية حياتي عالمًا غيره. وهذه النشأة وسط وعي البشر تفسر كثيرًا مما سأحكيه هنا.


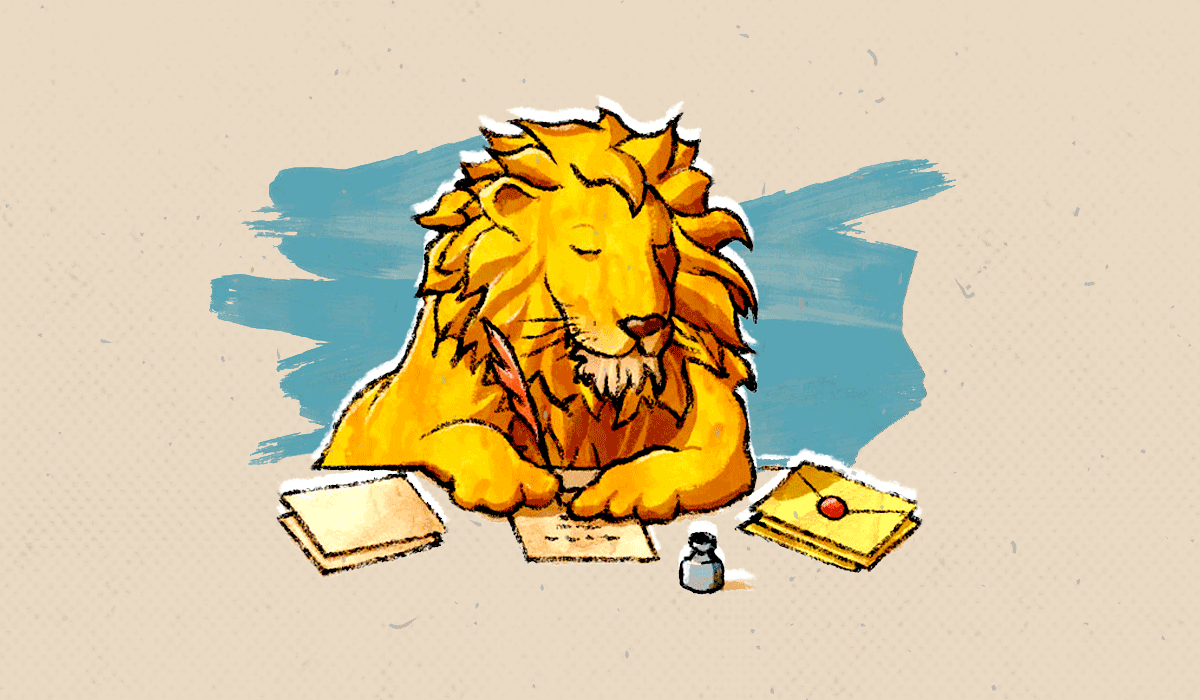
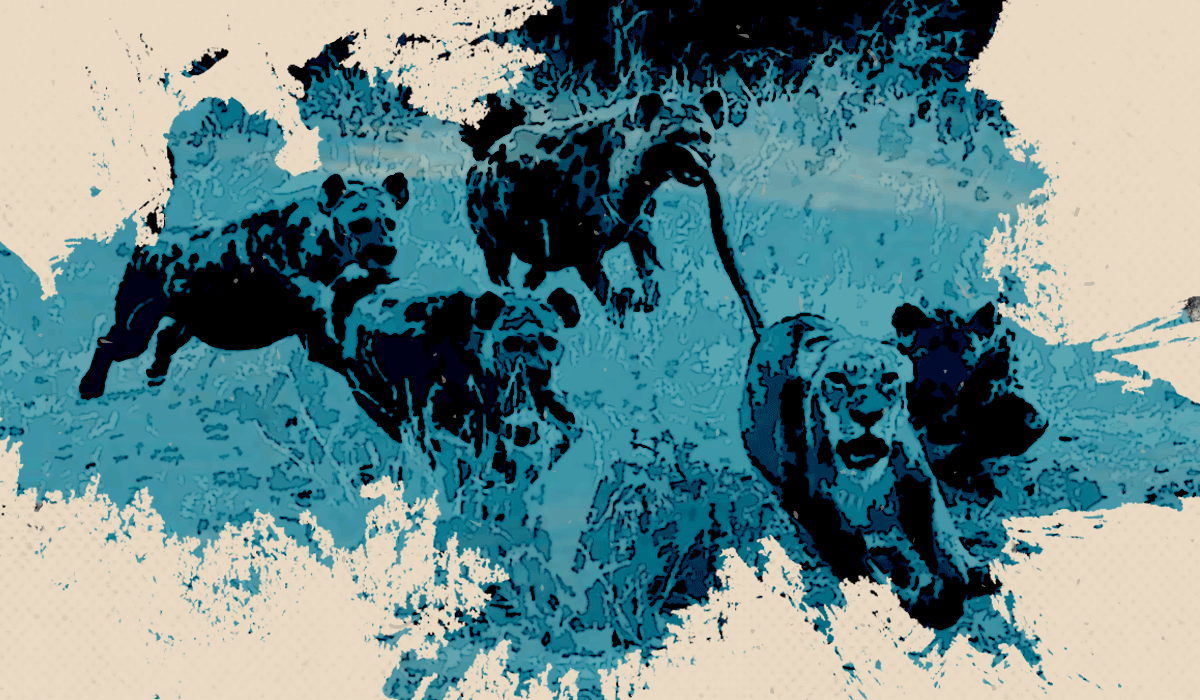











 موضوعات متعلقة
موضوعات متعلقة