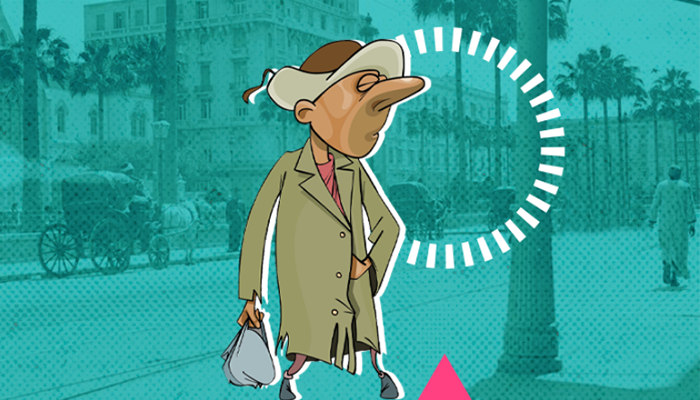
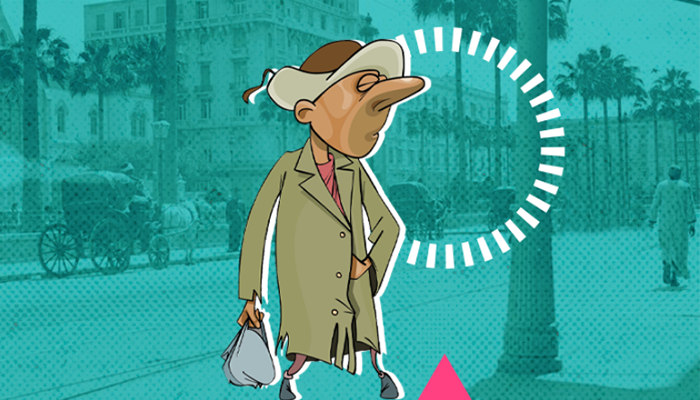



في بنايتنا السكنية في لندن، وفد ساكن جديد كان يترك القمامة على باب الغرفة المخصصة لها، بدل أن يدخل ويضعها في الحاويات المجهزة للغرض.
ترك له السكان خطاب تهديد شديد اللهجة، ينذره إن عاد إلى هذه الفعلة بأن السكان سيفتحون كيس القمامة ويتعرفون عليه ويبلغون البلدية.
فتوقف.
هنا أجبرت الجماعة الفرد على حد أدنى من الحفاظ على الجوار. وعلى نبذ الرثاثة. ربما الدافع المباشر لتدخلهم البعد الجمالي، والسلوكي. لكن دافعا آخر أبعد من هذا … الدفع الاقتصادي.
ترك الزبالة خارج حاوياتها ينقص القيمة السوقية للعقار، لو أتى مستأجر لاستئجار شقة أو مشتر لشرائها. القيمة الاقتصادية المنقوصة تساوي آلاف في الإيجار السنوي، وتساوي عشرات الآلاف في ثمن البيع. والتأثير لا يتوقف عادة على هذا العقار بعينه.
متوسط سعر الوحدة السكنية في الشارع كله سينخفض. وهو المؤشر الذي يلجأ إليه المشترون عادة لتقييم عقار في حي ما.
كل ملاك الشقق في البناية إذن، كما ملاك الشقق في البنايات المجاورة، من مصلحتهم الاقتصادية ألا يترك أحد كيس القمامة هذا، وهم يدافعون عن مصلحتهم الاقتصادية.
المجتمع لم يترك الموضوع للنيات، ولا المعايير الجمالية – رغم أهميتها – بل إن العرض والطلب وارتفاع وانخفاض القيمة الاقتصادية للوحدات خلق حافزا للمحافظة عليها.
التغير في القيمة حسب النظافة والمظهر مرتبط بوجود قيمة معيارية. أي مرتبط بوجود أناس تحافظ على أحيائها نظيفة، فترتفع قيمتها السوقية. وتنخفض بالتالي القيمة السوقية في الأحياء الرثة المهملة أو القذرة.
لو أخرجنا عامل الفخامة/ الرثاثة من المعادلة في عموم البلد، لو نجحنا في جعل البلد كلها رثة فلن تعود هناك قيمة معيارية نقيس عليها.
انتبه للعبارة السابقة لأننا سنحتاجها في فهم سلوك بعض الراغبين في تعميم الرثاثة.
هذا الرشد الاجتماعي/ الاقتصادي هو الأساس في مقولة “ديمقراطية متملكي المنازل”. أي ديمقراطية أصحاب المصلحة في اختيار القرار السياسي السليم. ديمقراطية من لا يملكون قيمة اقتصادية يخشون من انهيارها قد تخلق مصلحة في شد الآخرين إلى أسفل، وتعميم الغلب.


تخيل حالة عكسية. لو ذهب فريد ذو الحس الفني إلى منطقة لا تهتم بالجماليات، ولا بألوان البيوت. أو ذهب الأستاذ نظيف إلى منطقة المعتاد فيها إلقاء الزبالة في الشارع.
هل سيغير فرد مسار الجماعة؟
غالبًا لا.
الجماعة ستفرض عليهما الضوضاء التي تريد، وقد تنهر الأستاذ فريد لو حاول استخدام حقه في الضوضاء ولكن ببعض الموسيقى، أو سأل من حوله تلوين واجهات المنازل.
أما الأستاذ نظيف فنتمنى ألا يحبط ويقول “أهي خربانة خربانة” ويبدأ في إلقاء الزبالة.
ليس لنا أمل أكبر من ذلك. فمن الصعب لفرد أن يرغم آلافًا على التخلي عن هكذا سلوك. ولو فعل لاتهم أيضًا بالتعالي، وافتعال المشاكل.
الإنسان وجواره كسائل في أوان مستطرقة.. إن شعر أنه أقل من جواره المهيمن لن يتحمل الخزي، سيرفع من حال نفسه، وإن شعر الجوار المهيمن أن شخصًا ما أفضل منه سيشده إلى أسفل، فيتخلص من ضغط الإحساس بأنه في مستوى أخفض.
هذا واضح كالشمس. يعاينه كل واحد فينا في الجوار الذي يسكن فيه.
لكن المجتمع يعمل أيضا بطرق أخفى.
في طفولتي مثلًا، كان من المعتاد لأبي وأمي أن يصطحبوني وأخوي لزيارة جيراننا في البناية، وأصدقاء العمل الذين يسكنون في مناطق أخرى. لكن في جيلي تكاد هذه الزيارات العائلية تختفي من أوساط الطبقة الوسطى، لتقتصر على زيارات الأهل.
هذا التزاور الاجتماعي كان إيجابيًا بالنظر إلى خاصية الأواني المستطرقة التي تحدثنا عنها. المضيف يظهر للضيف أجمل ما عنده. والضيف يحاول أن يباريه في التجمل استعدادًا لرد الزيارة. فتزاد البيوت جمالًا بلطف.
اختفاء عادة التزاور كان فعلًا من أفعال الخجل الاجتماعي. حملته معها موجات الهجرة الكاسحة من الريف إلى الحضر، واتخذت لفعلها مبررًا دينيًا تحت اسم تحريم الاختلاط.
ودعمه الشيوخ الريفيون وتلاميذهم الجالسون تحت أقدامهم في دروس التليفزيون وفي المساجد.
هذا نفس المنطق الذي غاب به الاختلاط بين الرجال والنساء على المستوى الفردي، بين الرجال والنساء. وهو اختلاط إيجابي آخر يجمل المجتمع ويهذب سلوكه، ويرفع مستوى الجمال فيه بلطف.
أدى الفصل بين الجنسين إلى تحييد الرغبة الطبيعية في التجمل لدى كل منهما سعيًا إلى جذب الجنس الآخر. أنا ومن أعرفهم من الرجال نعرف أن أفضل فترات عنايتنا بأنفسنا، وبأماكن إقامتنا، تكون في أوقات ارتباطنا بعلاقات نسائية، أو سعينا إليها.
من يريدون منع الاختلاط لن يكتفوا بمنع أنفسهم من الاختلاط. بل سيسعون بتصميم إلى فرض المنع على الآخرين. هذا شعور غريزي يمنعون به تجمل بقية أفراد المجموعة البشرية، وبالتالي حيازتهم صفات تفضيلية. باللغة التي استخدمناها سابقا، يريدون إلغاء القيمة المعيارية التي يمكن مقارنة حالتهم بها.
وهو نفس الشعور الغريزي الذي يجعلهم يطاردون النساء المتجملات، ويصرون على فرض “ما يحجب الجمال” على الجميع.
لو لم يفعلوا ذلك ستشعر نساء المجموعة المحجوبة بأزمة نفسية. وسترى كل يوم ما يذكرها بفارق الجمال بينها وبين غيرها من الإناث.
كل هذه الإجراءات وآلاف غيرها في دقائق حياتنا اليومية، تؤدي إلى انخفاض مستوى الجمال. إلى النزول نحو الرثاثة. خطوة خطوة. درجة درجة. حتى نصل إلى الشكل الذي نرى عليه شوارعنا.
ما يحكم رغبة الأشخاص في القضاء على الميزات التفضيلية لدى الآخرين، يحكم رغبتهم في القضاء الميزات التفضيلية في الأحياء السكنية، لو استطاعوا.
وما يحكم رغبتهم في إشانة تجمل النساء، هو ما يحكم رغبتهم في إشانة تجمل كمباوند أو منطقة سكنية فخمة.
الكارثة أن يجدوا لهذه الرغبة دعمًا من نخبة سياسية أو ثقافية



هل امتنع التفاح عن السقوط من الشجر في انتظار اكتشاف الإنسان لقوانين الجاذبية!
اكتشاف الإنسان لهذه القوانين جعله يستفيد من قوى الكون الطبيعية. أما قوى الكون نفسها، فأزلية أبدية.
هكذا الاقتصاد في عالم البشر، كالفيزياء في الكون. إله حاكم، لا يرسل أنبياء، ولا يهدد بعذاب في الآخرة. ولماذا يفعل؟
يكفيه الطعام والشراب والملبس والمسكن والممشى أنبياء، كل هذه مؤشرات اقتصادية يصحو عليها الأنام، ولا ينام أحدهم إلا بعد أن يوفيها. العقاب لمن يهملها عاجل غير آجل. يحدث في التو. في هذه الحياة الدنيا. يحدث للفرد المهمل في الاقتصاد. ويحدث للجماعة المفرطة فيه.
لا يهم جدالك الاقتصادي، ولا القوانين التي تفرضها لكي ترسخ رغباتك الاقتصادية وشعاراتك. المهم هل هذه القوانين تحاكي المعادلات القائمة بالفعل أم لا، وقادرة، كما قوانين نيوتن في الفيزياء، على الصمود أم لا.
صمودها ليس نابعًا من أنها تصيبك بالقشعريرة حين تسمعها، أو تجري الدمع من عيونك من فرط “إنسانيتها”. أو تظهرك أكثر رأفة وتعاطفًا من غيرك.
لكي يتوافق الاقتصاد مع الطبيعة لا بد له من احترام القاعدة الأساسية، أن يكون الفرد قادرا على كفالة نفسه ومن يعول. أن تكون تلك القاعدة، وما عداها استثناء له أسبابه القهرية.
الاقتصاد الناجح هو الذي ينطلق من سياسة تدعم هذه القاعدة الابتدائية، فيحصر فشل الأفراد في تحقيقها في أضيق نطاق.
والاقتصاد الفاشل هو الذي يطمئن الفرد إلى أنه مكفول في كل الأحوال، بل ويمنحه محفزات لكي يلد في فقره المزيد، مطمئنًا إلى أن المجتمع سيحمل عبئهم على كتفيه.
حين تخالف هذا القانون الطبيعي الاستفتاحي الأولي، فثق تماما أن الاقتصاد لا يغفل عن صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لن تشرب على مقهاه مشروبًا ولا تحاسب عليه.
سينخفض مستوى معيشة الجماعة. قد تتحمل هذا في ظرف طارئ وتكفل القاعد. لكن إن ولد مزيدًا من المكفولين بلا كافل سينخفض المستوى أكثر. ثم أكثر. ثم أكثر.
حتى الرثاثة.
هل فكرت لماذا تدهور شارع عريق مثل حي الظاهر، كان في وقت من الأوقات درة من درر الطبقة الوسطى في القاهرة؟ كما تشهد على ذلك حتى الآن المدارس الفرنسية المنتشرة فيه.
الإجابة ببساطة أنه تحول إلى حي “غير اقتصادي”. معادلته الاقتصادية ليست مستقيمة. عوائده لم تعد تكفي لصيانته واستدامته، واستمرار تفرده. لم يعد مغريا بـ “الاستثمار فيه”.
كان من المفترض أن تكون قيمة المبنى في الظاهر حاليًا عشرات ملايين الجنيهات. إنما قيمته الفعلية، عوائده الاستثمارية، لا تساوي أكثر من ثمن ثلاث علب سجائر شهريًا.
هل من المنطقي أن ينفق صاحب مبنى في حي الظاهر ملايين على صيانة أصل رأسمالي لا يعود عليه إلا بـ ١٢٠ جنيهًا شهريًا؟! لو فعل سيكون غبيًا. لم يكتف بالضرر الناتج عن تدهور القيمة العائدة من ممتلكاته – بسبب القوانين الاقتصادية الاشتراكية – بل أصر على أن يضر نفسه أكثر، ويصيب نفسه بالحسرة أكثر.
القرار الاقتصادي السليم بالنسبة له كفرد، بلا شك، أن يترك المبنى يتدهور (رثاثة)، وليته ينهار.
هنا، وبسبب القرار الاقتصادي للإدارة السياسية، تحولت المعادلة، فصارت الرثاثة أخف الضررين. بعبارة أخرى، لم يعد الجمال مجديًا اقتصاديًا، بل صار فعليًا خسارة اقتصادية مضاعفة.
ثم نعود لنشكو من العمارات التي كانت مثل عمارات أوروبا والآن صارت مسخًا. نشكو في النهار، وندعم السياسات التي أدت إلى هذا في الليل.
قصة حي الظاهر هي قصة كل أحياء الطبقة الوسطى في مصر، بدرجة أو بأخرى، وهي قصة أحياء الطبقة الوسطى مع اختلاف التفاصيل في بغداد ودمشق والجزائر العاصمة.
مشكلة نابعة من “الرثاثة الفكرية”، الأفكار التي لا تبالي بجودة الناتج عنها في الحياة المادية. وإن علمت لن تسميه رثاثة، ستسميه بساطة، أو عدالة، أو كفالة. أفكار غير مرئية رأي العين. وكل ما يفعله الاقتصاد أنه يحولها إلى صورة مادية مرئية. حذاؤك الرث، بنطالك رخيص الخامة، شوارعك التي تملؤها الزبالة، بناياتك القبيحة… كل هذه أفكارك الرثة مجمدة لكي تراها بعينيك.
هذه الرثاثة في أحياء الطبقة الوسطى. أما الرثاثة في الأحياء العشوائية،لا تقل الفقيرة، فحيرني فيها سؤال مختلف تماما.


كثير من البنايات العشوائية الرثة التي تراها في القاهرة بناها مليونيرات من بلدي، سوهاج.
وكثير من هؤلاء نشأوا في بيئة ريفية ولديهم بيوت ريفية، أبعد ما تكون عن الرثاثة، اهتمام الواحد فيهم بجلبابه وسيارته لا يباريه فيه غيره. كريم العطاء كنهر، ماله الخاص يفيض ليتكفل بأسر بأكملها.
لكنه إذ ينتقل إلى بيئته القاهرية المستحدثة لا يبالي. يعض على حيز وجوده كأنه سيتملكه أبدًا، ويعامله بلا مبالاة كأنه سيفقده غدًا.
في تسونامي الهجرة المصرية وفد ملايين بهذه العقلية، كان هؤلاء الأثرياء منهم.
وشاركهم في نفس العقلية فقراء أيضًا.. لم تكن وفادتهم إلى القاهرة قرارًا فرديًا مختارًا. بل حملته الأمواج إليه وألقت به. دخل مدرسة لا تكلفه شيئًا، ثم جامعة لا تكلفه شيئًا، والآن سيعمل تلقائيًا في وظيفة حكومية في العاصمة. أو لفظه الفقر فجاء يعمل في المعمار ويعيش في ظروف غير آدمية. يكرهها وتكرهه.
ماذا يجمع هؤلاء؟ ما الذي يجعلهم جميعا متفقين على الرثاثة، ومنهم أغنياء ومنهم فقراء. ومنهم متعلمون ومنهم أميون؟
الظاهرة نفسها رأيتها في مجتمعات المهجرين في بيروت. أغنى من غيرهم من المجتمعات، لكنهم لا يبالون بالمحيط.
عامل واحد فقط مشترك بين هؤلاء جميعًا، ولا شك أن له علاقة أيضا بالسلوك المشترك. إحساسهم أنها مسألة وقت، وأنهم عائدون يومًا ما إلى حيث ينتمون. عقلية المستأجر.
لو ابتعدت بالكاميرا قليلًا، فاتسعت دائرة اللقطة، سنكتشف أن هذا لا يبتعد عما ذكرناه من قبل. نفس عقلية المستأجر الذي تملك شقة بغير وجه حق، فلا رأى مصلحة للاستثمار فيها، ولا ترك مالكها الأصلي يستثمر فيها. ونفس عقلية من يعيش في هذا العالم وهو يعتقد أنه عالم مؤقت، وأن الحياة الحقيقية في عالم آخر. لكنه أيضا يعتقد أنه مالك هذه الأرض ووريثها. فلا هو يعمر فيها – لأنها فانية – ولا هو يترك غيره يستثمر فيها، لأنه الوريث الذي يجب أن “يسترجعها”.
يعضون على “ملكهم” كأنهم سيمتلكونه أبدًا .. ويهملون فيه كأنهم راحلون عنه غدًا.
تمشينا معا في جولة في الأحياء الرثة، والأفكار الرثة، لم يتبق لنا سوى مشهد واحد: هل كل الرثاثة سواء؟ هل من مخرج؟

الرثاثة، كما أراها، نوعان.
رثاثة اضطرار، لعوامل خارجة عن إرادة الفرد، لكنه معترف بها، ويدرك حاجته إلى تغييرها في أقرب فرصة.
ورثاثة اختيار. وهذه ناتجة عن أفكار تجد في الرثاثة أمانًا وألفة. وتسبغ عليها من الصفات الإيجابية ما يعبر عن فلسفة في النظرة إلى العالم.
رثاثة “التوحيد والنور” مثلا ليست ناتجة عن فقر، بل عن هذا الإخفاء المتعمد لأي جمال. رثاثة نابعة من إحساس عميق بالذنب إزاء الجمال، ناهيك عن الفخامة. يتشارك فيها المتدينون الخائفون من الفتنة، مع الاشتراكيين الشاعرين بالذنب، دون أن يمنعهم شعورهم هذا عن تحري العيش الرغد.
المتدينون من ثم يفرضون الرثاثة على أنفسهم وغيرهم،
أما الاشتراكيون فيروجونها لغيرهم فقط.
كلاهما ينظر إلى حياتنا كمعمل تجارب من أجل جائزة موجودة في جنة علوية تنتظره، أو في جنة أرضية لم تتحقق وينتظرها.
إحساس نفسي يقتل الطموح، ويعاند الطبيعة، لكن الأخطر أنه يمهد الانتقال من رثاثة الاضطرار إلى رثاثة الاختيار.
رثاثة الاضطرار مرحلة أولى في تدهور المجتمعات. على قدر ما فيها من سلبيات فيمكن تعديلها بتحسين الوضع الاقتصادي ووقف عجلة التدهور وتعديل القوانين.
رثاثة الاختيار مرحلة تشبه الإنكار في المرض النفسي. والإنكار في المرض النفسي علامة تفرق بين العصابية، التي علاجها أسهل، والذهانية، التي علاجها أصعب.
رثاثة الاختيار حالة نفسية، تجعل المجتمع يألف الرثاثة، ولا ينزعج منها. على الأقل لا ينزعج منها بالقدر الذي يجب. ولا ينزعج منها بقدر ما ينزعج من الفخامة والجمال.
يجعل المجتمع وافراده يسارعون بلا تردد إلى شن الحملات على افراد المجتمع الحريصين على العيش في مكان جميل، محافظ عليه، وعلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل استمرار هذا. بينما يترددون، ويشعرون بالذنب، إن انتقدوا الأحياء الرثة ولا سيما الناتجة عن تعميم الفقر والدالة عليه.
الفقر شيء سيئ للغاية، لو كان رجلًا لقتله علي ابن أبي طالب. الحكومات والقادة في أي مكان في الدنيا مهمتهم القضاء على الفقر. فلا تجعل ارتباط الرثاثة بالفقر في كثير من الأحيان حصنا للرثاثة من الانتقاد. كلاهما سيئ ويستحق الانتقاد. ما يستحق الثناء هو السعي للخروج منهما.
 موضوعات متعلقة
موضوعات متعلقة